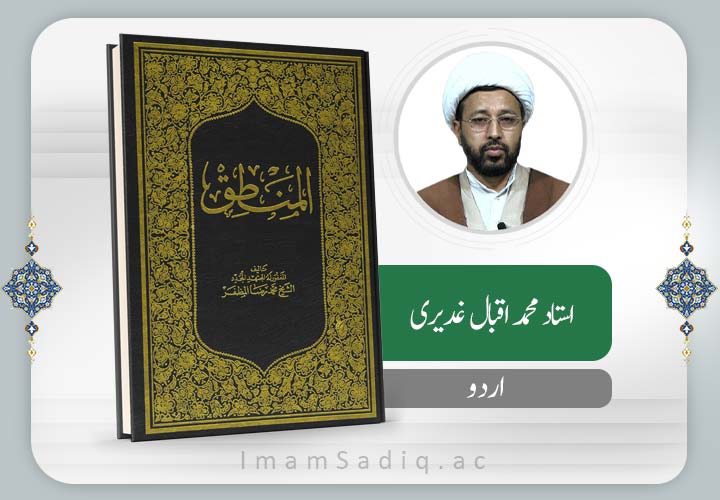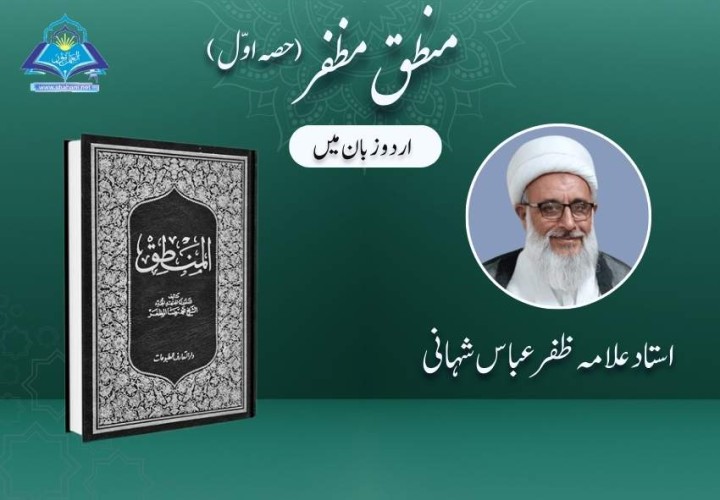المدخل: الحاجه الی المنطق
خلق الله الإنسان مفطوراً على النطق، وجعل اللسان آلة ینطق بها ولکن - مع ذلک - یحتاج إلى ما یقوم نطقه ویصلحه لیکون کلامه على طبق اللغة التی یتعلمها، من ناحیة هیئات الألفاظ وموادها: فیحتاج - أولاً - إلى المدرب الذی یعوَّده على ممارستها، و - ثانیاً - إلى قانون یرجع إلیه یعصم لسانه عن الخطأ. وذلک هو النحو والصرف. وکذلک خلق الله الإنسان مفطوراً على التفکیر بما منحه من قوة عاقلة مفکرة، لا کالعجماوات. ولکن - مع ذلک - نجده کثیر الخطأ فی أفکاره: فیحسب ما لیس بعلة علة، وما لیس بنتیجة لأفکاره نتیجة، وما لیس ببرهان برهاناَ، وقد یعتقد بأمر فاسد أو صحیح من مقدمات فاسدة... وهکذا. فهو- إذن - بحاجة إلى ما یصحح أفکاره ویرشده إلى طریق الاستنتاج الصحیح، ویدرِّبه على تنظیم أفکاره وتعدیلها.
وقد ذکروا أن (علم المنطق) هو الأداة التی یستعین بها الإنسان على العصمة من الخطأ، وترشده إلى تصحیح أفکاره، فکما أن النحو والصرف لا یعلمان الإنسان النطق وإنما یعلمانه تصحیح النطق، فکذلک علم المنطق لا یعلم الإنسان التفکیر، بل یرشده إلى تصحیح التفکیر
. إذن فحاجتنا إلى المنطق هی تصحیح أفکارنا. وما أعظمها من حاجة! ولو قلتم: أن الناس یدرسون المنطق ویخطئون فی تفکیرهم فلا نفع فیه، قلنا لکم: أن الناس یدرسون علمی النحو والصرف، ویخطئون فی نطقهم، ولیس ذلک إلا لأن الدارس للعلم لا یحصل على ملکة العلم، أو لا یراعی قواعده عند الحاجة، أو یخطئ فی تطبیقها، فیشذ عن الصواب.
تعریف علم المنطق
و لذلک عرفوا علم المنطق بأنه (آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فی الفکر).
فانظر إلى کلمة (مراعاتها)، واعرف السر فیها کما قدمناه، فلیس کل من تعلم المنطق عُصم عن الخطأ فی الفکر، کما أنه لیس کل من تعلم النحو عُصم عن الخطأ فی اللسان، بل لابد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة، لیعصم ذهنه أو لسانه.
المنطق آلة:
وانظر إلى کلمة (آلة) فی التعریف وتأمل معناها، تعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلیة التی تستخدم لحصول غایة، هی غیر معرفة نفس مسائل العلم، فهو یتکفل ببیان الطرق العامة الصحیحة التی یتوصل بها الفکر إلى الحقائق المجهولة، کما یبحث (علم الجبر) عن طرق حل المعادلات التی بها یتوصل الریاضی إلى المجهولات الحسابیة.
وببیان أوضح: علم المنطق یعلمک القواعد العامة للتفکیر الصحیح حتى ینتقل ذهنک إلى الأفکار الصحیحة فی جمیع العلوم، فیعلمک على أیة هیئة وترتیب فکری تنتقل من الصور الحاضرة فی ذهنک إلى الأمور الغائبة عنک - ولذا سموا هذا العلم (المیزان) و(المعیار) من الوزن والعیار، ووسموه بأنه (خادم العلوم) حتى علم الجبر الذی شبهنا هذا العلم به، یرتکز حل مسائله وقضایاه علیه.
فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال التمرینات لهذه الأداة وإجراء عملیتها فی أثناء الدراسة، شأن العلوم الریاضیة والطبیعیة.
العلم - تمهید
قلنا: إن الله تعالى خلق الإنسان مفطوراً على التفکیر مستعداً لتحصیل المعارف بما أعطی من قوة عاقلة مفکرة یمتاز بها عن العجماوات. ولا بأس ببیان موطن هذا الامتیاز من أقسام العلم الذی نبحث عنه، مقدمة لتعریف العلم ولبیان علاقة المنطق به، فنقول:
1- إذا ولد الإنسان یولد وهو خالی النفس من کل فکرة وعلم فعلی، سوى هذا الاستعداد الفطری. فإذا نشأ وأصبح ینظر ویسمع ویذوق ویشم ویلمس، نراه یحس بما حوله من الأشیاء ویتأثر بها التأثر المناسب، فتنفعل نفسه بها، فنعرف أن نفسه التی کانت خالیة أصبحت مشغولة بحالة جدیدة نسمیها (العلم)، وهی العلم الحسی الذی هو لیس إلا حس النفس بالأشیاء التی تنالها الحواس الخمس: (الباصرة، السامعة، الشامة، الذائقة، اللامسة). وهذا أول درجات العلم، وهو رأس المال لجمیع العلوم التی یحصل علیها الإنسان، ویشارکه فیه سائر الحیوانات التی لها جمیع هذه الحواس أو بعضها.
2- ثم تترقى مدارک الطفل فیتصرف ذهنه فی صور المحسوسات المحفوظة عنده، فینسب بعضها إلى بعض: هذا أطول من ذاک، وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله... ویؤلف بعضها من بعض تألیفاً قد لا یکون له وجود فی الخارج، کتألیفه لصور الأشیاء التی یسمع بها ولا یراها، فیتخیل البلدة التی لم یرها، مؤلفة من الصور الذهنیة المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان. وهذا هو (العلم الخیالی) یحصل علیه الإنسان بقوة (الخیال)، وقد یشارکه فیه بعض الحیوانات.
3- ثم یتوسع فی إدراکه إلى أکثر من المحسوسات، فیدرک المعانی الجزئیة التی لا مادة لها ولا مقدار: مثل حب أبویه له وعداوة مبغضیه، وخوف الخائف، وحزن الثاکل، وفرح المستبشر... وهذا هو (العلم الوهمی) یحصل علیه الإنسان کغیره من الحیوانات بقوة (الوهم). وهی - هذه القوة - موضع افتراق الإنسان عن الحیوان، فیترک الحیوان وحده یدبر إدراکاته بالوهم فقط ویصرفها بما یستطیعه من هذه القوة والحول المحدود.
4- ثم یذهب هو - الإنسان - فی طریقه وحده متمیزاً عن الحیوان بقوة العقل والفکر التی لا حد لها ولا نهایة، فیدیر بها دفة مدرکاته الحسیة والخیالیة والوهمیة، ویمیز الصحیح منها عن الفاسد، وینتزع المعانی الکلیة من الجزئیات التی أدرکها فیتعقلها، ویقیس بعضها على بعض، وینتقل من معلوم إلى آخر، ویستنتج ویحکم، ویتصرف ما شاءت له قدرته العقلیة والفکریة. وهذا (العلم) الذی یحصل للإنسان بهذه القوة هو العلم الأکمل الذی کان به الإنسان إنساناً، ولأجل نموه وتکامله وضعت العلوم وألفت الفنون، وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس. وعلم المنطق وضع من بین العلوم، لأجل تنظیم تصرفات هذه القوة خوفاً من تأثیر الوهم والخیال علیها. ومن ذهابها فی غیر الصراط المستقیم لها.
تعریف العلم
وقد تسأل على أی نحو تحصل للإنسان هذه الإدراکات؟ ونحن قد قربنا لک فیما مضى نحو حصول هذه الإدراکات بعض الشیء، ولزیادة التوضیح نکلفک أن تنظر إلى شیء أمامک ثم تطبق عینیک موجهاً نفسک نحوه، فستجد فی نفسک کأنک لا تزال مفتوح العینین تنظر إلیه، وکذلک إذا سمعت دقات الساعة - مثلاً - ثم سددت أذنیک موجهاً نفسک نحوها، فستحس من نفسک کأنک لا تزال تسمعها... وهکذا فی کل حواسک. إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جیداً یسهل علیک أن تعرف أن الإدراک أو العلم إنما هو انطباع صور الأشیاء فی نفسک لا فرق بین مدرکاتک فی جمیع مراتبها، کما تنطبع صور الأشیاء فی المرآة. ولذلک عرفوا العلم بأنه: «حضور صورة الشیء عند العقل». أو فقل انطباعه فی العقل، لا فرق بین التعبیرین فی المقصود.
التصور و التصدیق
إذا رسمت مثلثاً تحدث فی ذهنک صورة له، هی علمک بهذا المثلث، ویسمى هذا العلم (بالتصور). وهو تصور مجرد لا یستتبع جزماً واعتقاداً. وإذا تنبهت إلى زوایا المثلث تحدث لها أیضاً صورة فی ذهنک. وهی أیضاً من (التصور المجرد). وإذا رسمت خطاً أفقیاً وفوقه خطاً عمودیاً مقاطعاً له تحدث زاویتان قائمتان، فتنتقش صورة الخطین والزاویتین فی ذهنک. وهی من (التصور المجرد) أیضاً.
وإذا أردت أن تقارن بین القائمتین ومجموع زوایا المثلث، فتسأل فی نفسک هل هما متساویان؟ وتشک فی تساویهما، تحدث عندک صورة لنسبة التساوی بینهما وهی من (التصور المجرد) أیضاً.
فإذا برهنت على تساویهما تحصل لک حالة جدیدة مغایرة للحالات السابقة. وهی إدراکک لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحکم النفس وإذعانها وتصدیقها بالمطابقة. وهذه الحالة أیضاً (صورة المطابقة للواقع التی تعقلتها وأدرکتها) هی التی تسمى (بالتصدیق)، لأنها إدراک یستلزم تصدیق النفس وإذعانها، تسمیة للشیء باسم لازمه الذی لا ینفک عنه.
إذن، إدراک زوایا المثلث، وإدراک الزاویتین القائمتین، وإدراک نسبة التساوی بینهما کلها (تصورات مجردة) لا یتبعها حکم وتصدیق. أما إدراک أن هذا التساوی صحیح واقع مطابق للحقیقة فی نفس الأمر فهو (تصدیق).
وکذلک إذا أدرکت أن النسبة فی الخبر غیر مطابقة للواقع، فهذا الإدراک (تصدیق).
(تنبیه) :
إذا لاحظت ما مضى یظهر لک أن التصور والإدراک والعلم کلها ألفاظ لمعنى واحد، وهو: حضور صور الأشیاء عند العقل.
فالتصدیق أیضاً تصور ولکنه تصور یستتبع الحکم وقناعة النفس وتصدیقها. وإنما لأجل التمییز بین التصور المجرد أی غیر المستتبع للحکم، وبین التصور المستتبع له، سمی الأول (تصوراً) لأنه تصور محض ساذج مجرد فیستحق إطلاق لفظ (التصور) علیه مجرداً من کل قید، وسمی الثانی (تصدیقاً) لأنه یستتبع الحکم والتصدیق، کما قلنا تسمیة للشیء باسم لازمه.
بماذا یتعلق التصور و التصدیق؟
لیس للتصدیق إلا مورد واحد یتعلق به، وهو النسبة فی الجملة الخبریة عند الحکم والإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها.
وأما التصور فیتعلق بأحد أربعة أمور:
1- (المفرد) من اسم، وفعل «کلمة»، وحرف «أداة».
2- (النسبة فی الخبر) عند الشک فیها أو توهمها، حیث لا تصدیق، کتصورنا لنسبة السکنى فى المریخ - مثلاً - عندما یقال: «المریخ مسکون».
3- (النسبة فی الإنشاء) من أمر ونهی وتمن واستفهام... إلى آخر الأمور الإنشائیة التی لا واقع لها وراء الکلام، فلا مطابقة فیها للواقع خارج الکلام، فلا تصدیق ولا إذعان.
4- (المرکب الناقص) کالمضاف والمضاف إلیه، والشبیه بالمضاف، والموصول وصلته، والصفة والموصوف، وکل واحد من طرفی الجملة الشرطیة... إلى آخر المرکبات الناقصة التی لا یستتبع تصورها تصدیقاً وإذعانا: ففی قوله تعالى: {إِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا}، الشرط (تعدوا نعمة الله) معلوم تصوری والجزاء (لا تحصوها) معلوم تصوری أیضاً. وإنما کانا معلومین تصوریین لأنهما وقعا کذلک جزاءاً وشرطاً فى الجملة الشرطیة وإلا ففی أنفسهما لولاها کل منهما معلوم تصدیقی. وقوله (نعمة الله) معلوم تصوری مضاف. ومجموع الجملة معلوم تصدیقی.
اقسام التصدیق
ینقسم التصدیق إلى قسمین: یقین وظن، لأن التصدیق هو ترجیح أحد طرفی الخبر وهما الوقوع واللاوقوع سواء کان الطرف الآخر محتملاً أو لا فإن کان هذا الترجیح مع نفی احتمال الطرف الآخر بتاً فهو (الیقین)، وإن کان مع وجود الاحتمال ضعیفاً فهو (الظن).
وتوضیح ذلک: إنک إذا عرضت على نفسک خبراً من الأخبار فأنت لا تخلو عن إحدى حالات أربع: إما إنک لا تجوّز إلا طرفاً واحداً منه إما وقوع الخبر أو عدم وقوعه، وإما أن تجوّز الطرفین وتحتملهما معاً. والأول هو الیقین.
والثانی وهو تجویز الطرفین له ثلاث صور، لأنه لا یخلو إما أن یتساوى الطرفان فی الاحتمال أو یترجح أحدهما على الآخر: فإن تساوى الطرفان فهو المسمى (بالشک) وإن ترجح أحدهما فإن کان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو (الظن) الذی هو من أقسام التصدیق. وإن کان الراجح الطرف الآخر فهو (الوهم) الذی هو من أقسام الجهل وهو عکس الظن. فتکون الحالات أربعاً، ولا خامسة لها:
1- (الیقین) وهو أن تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل کذبه أو تصدق بعدمه ولا تحتمل صدقه، أی أنک تصدق به على نحو الجزم وهو أعلى قسمی التصدیق.
2- (الظن) وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجویز الطرف الآخر، وهو أدنى قسمی التصدیق.
3- (الوهم) وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجیح الطرف الآخر.
4- (الشک) وهو أن یتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم.
(تنبیه):
یعرف مما تقدم أمران:
(الأول): أن الوهم والشک لیسا من أقسام التصدیق بل هما من أقسام الجهل.
و(الثانی): أن الظن والوهم دائماً یتعاکسان: فإنک إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه، وإذا کنت تتوهم عدمه فإنک تظن بمضمونه، فیکون الظن لأحد الطرفین توهماً للطرف الآخر.
الجهل و اقسامه
لیس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمکن منه، فالجمادات والعجماوات لا نسمیها جاهلة ولا عالمة، مثل العمى، فإنه عدم البصر فیمن شأنه أن یبصر، فلا یسمى الحجر أعمى. وسیأتی أن مثل هذا یسمى (عدم ملکة) ومقابله وهو العلم أو البصر یسمى (ملکة)، فیقال أن العلم والجهل متقابلان تقابل الملکة وعدمها.
والجهل على قسمین کما أن العلم على قسمین لأنه یقابل العلم فیبادله فی موارده فتارة یبادل التصور أی یکون فی مورده وأخرى یبادل التصدیق أی یکون فی مورده، فیصح بالمناسبة أن نسمی الأول (الجهل التصوری) والثانی (الجهل التصدیقی).
ثم إنهم یقولون أن الجهل ینقسم إلى قسمین: بسیط ومرکب. وفی الحقیقة أن الجهل التصدیقی خاصة هو الذی ینقسم إلیهما، ولهذا اقتضى أن نقسم الجهل إلى تصوری وتصدیقی ونسمیهما بهذه التسمیة. وأما الجهل التصوری فلا یکون إلا بسیطاً کما سیتضح.
ولنبین القسمین فنقول:
1- (الجهل البسیط) أن یجهل الإنسان شیئاً وهو ملتفت إلى جهله فیعلم أنه لا یعلم، کجهلنا بوجود السکان فی المریخ، فإنا نجهل ذلک ونعلم بجهلنا فلیس لنا إلا جهل واحد.
2- (الجهل المرکب) أن یجهل الإنسان شیئاً وهو غیر ملتفت إلى أنه جاهل به، بل یعتقد أنه من أهل العلم به، فلا یعلم أنه لا یعلم، کأهل الاعتقادات الفاسدة الذین یحسبون أنهم عالمون بالحقائق، وهم جاهلون بها فی الواقع.
ویسمون هذا مرکباً ﻷنه یترکب من جهلین: الجهل بالواقع والجهل بهذا الجهل. وهو أقبح وأهجن القسمین. ویختص هذا فی مورد التصدیق ﻷنه لا یکون إلاّ مع الاعتقاد.
لیس الجهل المرکب من العلم:
یزعم بعضهم دخول الجهل المرکب فی العلم فیجعله من أقسامه، نظراً إلى أنه یتضمّن الاعتقاد والجزم وإن خالف الواقع. ولکنا إذا دقّقنا تعریف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب وأنه أی هذا الزعم من الجهل المرکب، ﻷن معنى (حضور صورة الشیء عند العقل) أن تحضر صورة نفس ذلک الشیء أما إذا حضرت صورة غیره بزعم أنها صورته فلم تحضر صورة الشیء، بل صورة شیء آخر زاعماً أنها هی. وهذا هو حال الجهل المرکب، فلا یدخل تحت تعریف العلم. فمن یعتقد أن اﻷرض مسطحة لم تحضر عنده صورة النسبة الواقعیة وهی أن اﻷرض کرویة، وإنما حضرت صورة نسبة أخرى یتخیل أنها الواقع.
وفی الحقیقة أن الجهل المرکب یتخیل صاحبه أنه من العلم، ولکنه لیس بعلم. وکیف یصح أن یکون الشیء من أقسام مقابله، والاعتقاد لا یغیر الحقائق، فالشبح من بعید الذی یعتقده الناظر إنساناً وهو لیس بإنسان لا یصیره الاعتقاد إنساناً على الحقیقة.
العلم ضروری و نظری
ینقسم العلم بکلا قسمیه التصوری والتصدیقی إلى قسمین:
1- (الضروری) ویسمى أیضاً (البدیهی) وهو ما لا یحتاج فی حصوله إلى کسب ونظر وفکر، فیحصل بالاضطرار وبالبداهة التی هی المفاجأة والارتجال من دون توقف، کتصورنا لمفهوم الوجود والعدم ومفهوم الشیء وکتصدیقنا بأن الکل أعظم من الجزء وبأن النقیضین لا یجتمعان وبأن الشمس طالعة وأن الواحد نصف الاثنین وهکذا...
2- و(النظری) وهو ما یحتاج حصوله إلى کسب ونظر وفکر، کتصورنا لحقیقة الروح والکهرباء، وکتصدیقنا بأن الأرض ساکنة أو متحرکة حول نفسها وحول الشمس ویسمى أیضاً (الکسبی).
(توضیح القسمین):
إن بعض الأمور یحصل العلم بها من دون إمعان نظر وفکر فیکفی فی حصوله أن تتوجه النفس إلى الشیء بأحد أسباب التوجه الآتیة من دون توسط عملیة فکریة کما مثلنا، وهذا هو الذی یسمى (بالضروری أو البدیهی) سواء أکان تصوراً أم تصدیقاً. وبعضها لا یصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة، بل لابد من إمعان النظر وإجراء عملیات عقلیة ومعادلات فکریة کالمعادلات الجبریة، فیتوصل بالمعلومات عنده إلى العلم بهذه الأمور (المجهولات)، ولا یستطیع أن یتصل بالعلم بها رأساً من دون توسیط هذه المعلومات وتنظیمها على وجه صحیح، لینتقل الذهن منها إلى ما کان مجهولاً عنده، کما مثلنا. وهذا هو الذی یسمى (بالنظری أو الکسبی) سواء کان تصوراً أو تصدیقاً.
توضیح فی الضروری:
قلنا: إن العلم الضروری هو الذی لا یحتاج إلى الفکر وإمعان النظر. وأشرنا إلى أنه لابد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه. وهذا ما یحتاج إلى بعض البیان:
فإن الشیء قد یکون بدیهیاً ولکن یجهله الإنسان، لفقد سبب توجه النفس، فلا یجب أن یکون الإنسان عالماً بجمیع البدیهیات، ولا یضر ذلک ببداهة البدیهی. ویمکن حصر أسباب التوجه فی الأمور التالیة:
1- (الإنتباه) وهذا السبب مطرد فی جمیع البدیهیات، فالغافل قد یخفى علیه أوضح الواضحات.
2- (سلامة الذهن) وهذا مطرد أیضاً، فإن من کان سقیم الذهن قد یشک فی أظهر الأمور أو لا یفهمه.
وقد ینشأ هذا السقم من نقصان طبیعی أو مرض عارض أو تربیة فاسدة.
3- (سلامة الحواس) وهذا خاص بالبدیهیات المتوقفة على الحواس الخمس وهی المحسوسات. فإن الأعمى أو ضعیف البصر یفقد کثیراً من العلم بالمنظورات وکذا الأصم فی المسموعات وفاقد الذائقة فی المذوقات. وهکذا.
4- (فقدان الشبهة) والشبهة: أن یؤلف الذهن دلیلاً فاسداً یناقض بدیهة من البدیهیات ویغفل عما فیه من المغالطة، فیشک بتلک البدیهة أو یعتقد بعدمها. وهذا یحدث کثیراً فی العلوم الفلسفیة والجدلیات. فإن من البدیهیات عند العقل أن الوجود والعدم نقیضان وأن النقیضین لا یجتمعان ولا یرتفعان، ولکن بعض المتکلمین دخلت علیه الشبهة فی هذه البدیهة، فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة وسماها (الحال)، فهما یرتفعان عندها. ولکن مستقیم التفکیر إذا حدث له ذلک وعجز عن کشف المغالطة یردها ویقول إنها (شبهة فی مقابل البدیهة).
5- (عملیة غیر عقلیة) لکثیر من البدیهیات، کالاستماع إلى کثیرین یمتنع تواطؤهم على الکذب فی المتواترات، وکالتجربة فی التجربیات، وکسعی الإنسان لمشاهدة بلاد أو استماع صوت فی المحسوسات... وما إلى ذلک. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشیء إلى تجربة طویلة، مثلاً، وعناء عملی، فلا یجعله ذلک علماً نظریاً ما دام لا یحتاج إلى الفکر والعملیة العقلیة.
تعریف الفکر
نعرف مما سبق أن النظر - أو الفکر - المقصود منه «إجراء عملیة عقلیة فی المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب» والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب. وبتعبیر آخر أدق أن الفکر هو: «حرکة العقل بین المعلوم والمجهول».
وتحلیل ذلک: أن الإنسان إذا واجه بعقله المشکل (المجهول) وعرف أنه من أی أنواع المجهولات هو، فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع المشکل، وعندئذ یبحث فیها ویتردد بینها بتوجیه النظر إلیها، ویسعى إلى تنظیمها فی الذهن حتى یؤلف المعلومات التی تصلح لحل المشکل، فإذا استطاع ذلک ووجد ما یؤلفه لتحصیل غرضه تحرک عقله حینئذ منها إلى المطلوب، أعنی معرفة المجهول وحل المشکل.
فتمر على العقل - إذن - بهذا التحلیل خمسة أدوار:
1- مواجهة المشکل (المجهول).
2- معرفة نوع المشکل، فقد یواجه المشکل ولا یعرف نوعه.
3- حرکة العقل من المشکل إلى المعلومات المخزونة عنده.
4- حرکة العقل - ثانیاً - بین المعلومات، للفحص عنها وتألیف ما یناسب المشکل ویصلح لحله.
5- حرکة العقل - ثالثاً - من المعلوم الذی استطاع تألیفه مما عنده إلى المطلوب.
وهذه الأدوار الثلاثة الأخیرة أو الحرکات الثلاث هی الفکر أو النظر، وهذا معنى حرکة العقل بین المعلوم والمجهول. وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان فی تفکیره وهو لا یشعر بها، فإن الفکر یجتازها غالباً بأسرع من لمح البصر، على أنها لا یخلو منها إنسان فی أکثر تفکیراته، ولذا قلنا إن الإنسان مفطور على التفکیر.
نعم من له قوة الحدس یستغنی عن الحرکتین الأولیین، وإنما ینتقل رأساً بحرکة واحدة من المعلومات إلى المجهول. وهذا معنى (الحدس)، فلذلک یکون صاحب الحدس القوی أسرع تلقیاً للمعارف والعلوم، بل هو من نوع الإلهام وأول درجاته. ولذلک أیضاً جعلوا القضایا (الحدسیات) من أقسام البدیهیات، لأنها تحصل بحرکة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشکل، من دون کسب وسعی فکری، فلم یحتج إلى معرفة نوع المشکل ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده وفحصها وتألیفها.
ولأجل هذا قالوا: إن قضیة واحدة قد تکون بدیهیة عند شخص نظریة عند شخص آخر. ولیس ذلک إلا لأن الأول عنده من قوة الحدس ما یستغنی به عن النظر والکسب، أی ما یستغنی به عن الحرکتین الأولیین، دون الشخص الثانی فإنه یحتاج إلى هذه الحرکات الثلاث لتحصیل المعلوم بعد معرفة نوع المشکل.
ابحاث المنطق
علم المنطق إنما یُحتاج إلیه لتحصیل العلوم النظریة، لأنه هو مجموعة قوانین الفکر والبحث. أما الضروریات فهی حاصلة بنفسها، بل هی رأس المال الأصلی لکاسب العلوم یکتسب به لیربح المعلومات النظریة المفقودة عنده. فإذا اکتسب مقداراً من النظریات زاد رأس ماله بزیادة معلوماته، فیستطیع أن یکتسب معلومات أکثر، لأن ربح التاجر عادة یزید کلما زادت ثروته المالیة. وهکذا طالب العلم کلما اکتسب تزید ثروته العلمیة وتتسع تجارته، فیتضاعف ربحه. بل تاجر العلم مضمون الربح بالاکتساب لا کتاجر المال.
وعلم المنطق یبحث عن کیفیة تألیف المعلومات المخزونة عنده، لیتوصل بها إلى الربح بتحصیل المجهولات وإضافتها إلى ما عنده من معلومات: فیبحث تارة عن المعلوم التصوری ویسمى (المعرِّف)، لیتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوری، ویبحث أخرى عن المعلوم التصدیقی ویسمى (الحجة) لیتوصل به إلى العلم بالمجهول التصدیقی.
والبحث عن الحجة بنحوین: تارة من ناحیة هیئة تألیفها، وأخرى من ناحیة مادة قضایاها، وهو بحث الصناعات الخمس. ولکل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات. فأبحاث المنطق نضعها فی ستة أبواب:
الباب الأول - فی مباحث الألفاظ
الباب الثانی - فی مباحث الکلی
الباب الثالث - فی المعرف وتلحق به القسمة (الجزء الأول)
الباب الرابع - فی القضایا وأحکامها
الباب الخامس - فی الحجة وهیئة تألیفها (الجزء
الثانی)
الباب السادس - فی الصناعات الخمس (الجزء الثالث).
*الباب الاول مباحث الالفاظ*
الحاجة إلى مباحث الألفاظ:
لا شک أن المنطقی لا یتعلق غرضه الأصلی إلا بنفس المعانی، ولکنه لا یستغنی عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلاً إلى المعانی، لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفکار بینهم لا یکون غالباً إلا بتوسط لغة من اللغات. والألفاظ قد یقع فیها التغییر والخلط فلا یتم التفاهم بها. فاحتاج المنطقی إلى أن یبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة، ومن غیر اختصاص بلغة من اللغات، إتماماً للتفاهم، لیزن کلامه وکلام غیره بمقیاس صحیح.
وقلنا: (من جهة عامة) لأن المنطق علم لا یختص بأهل لغة خاصة، وإن کان قد یحتاج إلى البحث عما یختص باللغة التی یستعملها المنطقی فیما قل: کالبحث عن دلالة لام التعریف - فی لغة العرب - على الاستغراق، وعن کان وأخواتها فی أنها من الأدوات والحروف، وعن أدوات العموم والسلب... وما إلى ذلک. ولکنه قد یستغنی عن إدخالها فی المنطق اعتماداً على علوم اللغة. هذه حاجته من أجل التفاهم مع غیره. وللمنطقی حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، هی أعظم وأشد من حاجته الأولى، بل لعلها هی السبب الحقیقی لإدخال هذه الأبحاث فی المنطق.
ونستعین على توضیح مقصودنا بذکر تمهید نافع، ثم نذکر وجه حاجة الإنسان فی نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتیجة للتمهید، فنقول:
(التمهید):
إن للأشیاء أربعة وجودات: وجودان حقیقیان ووجودان اعتباریان جعلیان:
الأول- (الوجود الخارجی) کوجودک ووجود الأشیاء التی حولک ونحوها، من أفراد الإنسان والحیوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم، إلى غیر ذلک من الوجودات الخارجیة التی لا حصر لها. الثانی- (الوجود الذهنی) وهو علمنا بالأشیاء الخارجیة وغیرها من المفاهیم. وقد قلنا سابقاً: أن للإنسان قوة تنطبع فیها صور الأشیاء. وهذه القوة تسمى الذهن. والانطباع فیها یسمى الوجود الذهنی الذی هو العلم.
وهذان الوجودان هما الوجودان الحقیقیان. لأنهما لیسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر.
الثالث- (الوجود اللفظی) بیانه: أن الإنسان لما کان اجتماعیاً بالطبع ومضطراً للتعامل والتفاهم مع باقی أفراد نوعه، فإنه محتاج إلى نقل أفکاره إلى الغیر وفهم أفکار الغیر. والطریقة الأولیة للتفهیم هی أن یحضر الأشیاء الخارجیة بنفسها، لیحس بها الغیر بإحدى الحواس فیدرکها. ولکن هذه الطریقة من التفهیم تکلفه کثیراً من العناء، على أنها لا تفی بتفهیم أکثر الأشیاء والمعانی، إما لأنها لیست من الموجودات الخارجیة أو لأنها لا یمکن إحضارها.
فألهم الله تعالى الإنسان طریقة سهلة سریعة فی التفهیم، بأن منحه قوة على الکلام والنطق بتقاطیع الحروف لیؤلف منها الألفاظ. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة - وهی أم الاختراع - إلى أن یضع لکل معنى یعرفه ویحتاج إلى التفاهم عنه لفظاً خاصاً. لیحضر المعانی بالألفاظ بدلاً من إحضارها بنفسها.
ولأجل أن تثبت فی ذهنک أیها الطالب هذه العبارة أکررها لک: (لیحضر المعانی بالألفاظ بدلاً من إحضارها بنفسها). فتأملها جیداً، واعرف أن هذا الإحضار إنما یتمکن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به فی الذهن. وهذا الارتباط القوی ینشأ من العلم بالوضع وکثرة الاستعمال. فإذا حصل هذا الارتباط القوی لدى الذهن یصبح اللفظ عنده کأنه المعنى والمعنى کأنه اللفظ أی یصبحان عنده کشیء واحد، فإذا أحضر المتکلم اللفظ فکأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا یکون فرق لدیه بین أن یحضر خارجاً نفس المعنى وبین أن یحضر لفظه الموضوع له، فإن السامع فی کلا الحالین ینتقل ذهنه إلى المعنى. ولذا قد ینتقل السامع إلى المعنى ویغفل عن اللفظ وخواصه کأنه لم یسمعه مع أنه لم ینتقل إلیه إلا بتوسط سماع اللفظ.
وزبدة المخض أن هذا الارتباط یجعل اللفظ والمعنى کشیء واحد، فإذا وجد اللفظ فکأنما وجد المعنى. فلذا نقول: «وجود اللفظ وجود المعنى». ولکنه وجود لفظی للمعنى، أی أن الموجود حقیقة هو اللفظ لا غیر، وینسب وجوده إلى المعنى مجازاً، بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع. والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ وبالعکس: فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب، وإن کان فی نفسه لفظاً وحشیاً ینفر منه السمع واللسان. واسم العدو من أسمج الألفاظ وإن کان فی نفسه لفظاً مستملحاً. وکلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، ولذا نرى اختلاف القبح فی الألفاظ المعبر بها عن المعانی القبیحة، نحو التعابیر عن عورة الإنسان، فکثیر الاستعمال أقبح من قلیله. والکنایة أقل قبحاً. بل قد لا یکون فیها قبح کما کنى القرآن الکریم بالفروج.
وکذا رصانة التعبیر وعذوبته یعطی جمالاً فی المعنى لا نجده فی التعبیر الرکیک الجافی، فیضفی جمال اللفظ على المعنى جمالاً وعذوبة.
الرابع- (الوجود الکتبی) شرحه: أن الألفاظ وحدها لا تکفی للقیام بحاجات الإنسان کلها، لأنها تختص بالمشافهین. أما الغائبون والذین سیوجدون، فلابد لهم من وسیلة أخرى لتفهیمهم، فالتجأ الإنسان أن یصنع النقوش الخطیة لإحضار ألفاظه الدالة على المعانی، بدلاً من النطق بها، فکان الخط وجوداً للفظ. وقد سبق أن قلنا: أن اللفظ وجود للمعنى، فلذا نقول: «إن وجود الخط وجود للفظ ووجود للمعنى تبعاً». ولکنه وجود کتبی للفظ والمعنى، أی أن الموجود حقیقة هو الکتابة لا غیر، وینسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازاً بسبب الوضع، کما ینسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازاً بسبب الوضع.
إذن الکتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعانی فی الذهن، والمعانی الذهنیة تدل على الموجودات الخارجیة.
فاتضح أن الوجود اللفظی والکتبی (وجودان مجازیان اعتباریان للمعنى) بسبب الوضع والاستعمال.
النتیجة:
لقد سمعت هذا البیان المطول - وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظی، وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بینهما کالشیء الواحد، فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فکأنما أحضرت المعنى بنفسه.
ومن هنا نفهم کیف یؤثر هذا الارتباط على تفکیر الإنسان بینه وبین نفسه، ألا ترى نفسک عندما تحضر أی معنى کان فی ذهنک لابد أن تحضر معه لفظه أیضاً، بل أکثر من ذلک تکون انتقالاتک الذهنیة من معنى إلى معنى بتوسط إحضارک لألفاظها فی الذهن: فإنا نجد أنه لا ینفک غالباً تفکیرنا فی أی أمر کان عن تخیل الألفاظ وتصورها کأنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجیها بالألفاظ التی نتخیلها، فنرتب الألفاظ فی أذهاننا، وعلى طبقها نرتب المعانی وتفصیلاتها، کما لو کنا نتکلم مع غیرنا.
قال الحکیم العظیم الشیخ الطوسی فی شرح الإشارات: «الانتقالات الذهنیة قد تکون بألفاظ ذهنیة، وذلک لرسوخ العلاقة المذکورة - یشیر إلى علاقة اللفظ بالمعنى - فی الأذهان». فإذا أخطأ المفکر فی الألفاظ الذهنیة أو تغیرت علیه أحوالها یؤثر ذلک على أفکاره وانتقالاته الذهنیة، للسبب المتقدم.
فمن الضروری لترتیب الأفکار الصحیحة لطالب العلوم أن یحسن معرفة أحوال الألفاظ من وجهة عامة، وکان لزاماً على المنطقی أن یبحث عنها مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظیم أفکاره الصحیحة.
الدلاله - تعریف و اقسام
تعریف الدلالة:
إذا سمعت طرقة بابک ینتقل ذهنک - لا شک - إلى أن شخصاً على الباب یدعوک. ولیس ذلک إلا لأن هذه الطرقة کشفت عن وجود شخص یدعوک. وإن شئت قلت: أنها (دلت) على وجوده. إذن، طرقة الباب (دال)، ووجود الشخص الداعی (مدلول) وهذه الصفة التی حصلت للطرقة (دلالة). وهکذا، کل شیء إذا علمت بوجوده، فینتقل ذهنک منه إلى وجود شیء آخر - نسمیه (دالاً)، والشیء الآخر (مدلولاً)، وهذه الصفة التى حصلت له (دلالة).
فیتضح من ذلک أن الدلالة هی: «کون الشیء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنک إلى وجود شیء آخر».
أقسام الدلالة:
لا شک أن انتقال الذهن من شیء إلى شیء لا یکون بلا سبب. ولیس السبب إلا رسوخ العلاقة بین الشیئین فی الذهن. وهذه العلاقة الذهنیة أیضاً لها سبب. وسببها العلم بالملازمة بین الشیئین خارج الذهن. ولاختلاف هذه الملازمة من کونها ذاتیة أو طبعیة أو بوضع واضع وجعل جاعل قسموا الدلالة إلى أقسام ثلاثة: عقلیة وطبعیة ووضعیة.
1- (الدلالة العقلیة) وهی فیما إذا کان بین الدال والمدلول ملازمة ذاتیة فی وجودهما الخارجی، کالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان - مثلاً - أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، ورأى الضوء على الجدار ینتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعاً، فیکون ضوء الصبح دالاً على الشمس دلالة عقلیة. ومثله إذا سمعنا صوت متکلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متکلم ما.
2- (الدلالة الطبعیة) وهی فیما إذا کانت الملازمة بین الشیئین ملازمة طبعیة، أعنی التی یقتضیها طبع الإنسان، وقد یتخلف ویختلف باختلاف طباع الناس، لا کالأثر بالنسبة إلى المؤثر الذی لا یتخلف ولا یختلف.
وأمثلة ذلک کثیرة، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن یقول: (آخ) عند الحس بالألم، و(آه) عند التوجع، و(أف) عند التأسف والتضجر. ومنها اقتضاء طبع البعض أن یفرقع أصابعه أو یتمطى عند الضجر والسأم، أو یعبث بما یحمل من أشیاء أو بلحیته أو بأنفه أو یضع إصبعه بین أعلى أذنه وحاجبه عند التفکیر، أو یتثأب عند النعاس.
فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ینتقل ذهنه من أحد المتلازمین إلى الآخر، فعندما یسمع بکلمة (آخ) ینتقل ذهنه إلى أن متکلمها یحس بالألم. وإذا رأى شخصاً یعبث بمسبحته یعلم بأنه فی حالة تفکیر... وهکذا.
3- (الدلالة الوضعیة) وهی فیما إذا کانت الملازمة بین الشیئین تنشأ من التواضع والاصطلاح على أن وجود أحدهما یکون دلیلاً على وجود الثانی، کالخطوط التی اصطلح على أن تکون دلیلاً على الألفاظ، وکإشارات الأخرس وإشارات البرق واللاسلکی والرموز الحسابیة والهندسیة ورموز سائر العلوم الأخرى، والألفاظ التی جعلت دلیلاً على مقاصد النفس.
فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال ینتقل ذهنه إلى الشیء المدلول.
أقسام الدلالة الوضعیة:
وهذه الدلالة الوضعیة تنقسم إلى قسمین:
أ - (الدلالة اللفظیة) إذا کان الدال الموضوع لفظاً.
ب - (الدلالة غیر اللفظیة) إذا کان الدال الموضوع غیر لفظ، کالإشارات والخطوط، والنقوش وما یتصل بها من رموز العلوم، واللوحات المنصوبة فی الطرق لتقدیر المسافات أو لتعیین اتجاه الطریق إلى محل أو بلدة... ونحو ذلک
الدلاله اللفظیه و اقسامها
تعریفها:
من البیان السابق نعرف أن السبب فی دلالة اللفظ على المعنى هو العلقة الراسخة فی الذهن بین اللفظ والمعنى. وتنشأ هذه العلقة - کما عرفت - من الملازمة الوضعیة بینهما عند من یعلم بالملازمة. وعلیه یمکننا تعریف الدلالة اللفظیة بأنها:
«هی کون اللفظ بحالة ینشأ من العلم بصدوره من المتکلم العلم بالمعنى المقصود به».
أقسامها:
المطابقیة. التضمنیة. الالتزامیة
یدلّ اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباینة:
(الوجه الأول) - المطابقة: بأن یدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له ویطابقه، کدلالة لفظ الکتاب على تمام معناه، فیدخل فیه جمیع أوراقه وما فیه من نقوش وغلاف، وکدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه، وهو الحیوان الناطق. وتسمى الدلالة حینئذ (المطابقیة) أو (التطابقیة)، لتطابق اللفظ والمعنى.
وهی الدلالة الأصلیة فی الألفاظ التی لأجلها مباشرة وضعت لمعانیها.
(الوجه الثانی) - التضمن: بأن یدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلک الجزء فی ضمنه، کدلالة لفظ الکتاب على الورق وحده أو الغلاف. وکدلالة لفظ الإنسان على الحیوان وحده أو الناطق وحده... فلو بعت الکتاب یفهم المشتری دخول الغلاف فیه، ولو أردت بعد ذلک أن تستثنی الغلاف لاحتج علیک بدلالة لفظ الکتاب على دخول الغلاف. وتسمى هذه الدلالة (التضمنیة). وهی فرع عن الدلالة المطابقیة، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الکل.
(الوجه الثالث) الالتزام: بأن یدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له لازم له یستتبعه استتباع الرفیق اللازم الخارج عن ذاته، کدلالة لفظ الدواة على القلم. فلو طلب منک أحد أن تأتیه بدواة لم ینص على القلم فجئته بالدواة وحدها لعاتبک على ذلک محتجاً بأن طلب الدواة کافٍ فی الدلالة على طلب القلم. وتسمى هذه الدلالة (الالتزامیة).
وهی فرع أیضاً عن الدلالة المطابقیة لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى.
شرط الدلاله الالتزامیه:
یشترط فی هذه الدلالة أن یکون التلازم بین معنى اللفظ والمعنى الخارج اللازم تلازماً ذهنیاً، فلا یکفی التلازم فی الخارج فقط من دون رسوخه فی الذهن وإلا لما حصل انتقال الذهن.
ویشترط - أیضاً - أن یکون التلازم واضحاً بیناً، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ینتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شیء آخر.
تقسیمات الالفاظ
للفظ المستعمل بما له من المعنى عدة تقسیمات عامة لا تختص بلغة دون أخرى، وهی أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلالة. ونحن ذاکرون هنا أهم تلک التقسیمات، وهی ثلاثة، لأن اللفظ المنسوب إلى معناه تارة ینظر إلیه فی التقسیم بما هو لفظ واحد، وأخرى بما هو متعدد، وثالثة بما هو لفظ مطلقاً سواء کان واحداً أو متعدداً.
المختص. المشترک. المنقول. المرتجل. الحقیقة والمجاز
إن اللفظ الواحد الدال على معناه بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة إذا نسب إلى معناه، فهو على أقسام خمسة، لأن معناه إما أن یکون واحداً أیضاً ویسمى (المختص)، وإما أن یکون متعدداً. وما له معنى متعدد أربعة أنواع: مشترک، ومنقول، ومرتجل، وحقیقة ومجاز، فهذه خمسة أقسام:
1 - (المختص) وهو اللفظ الذی لیس له إلا معنى واحد فاختص به، مثل حدید وحیوان.
2 - (المشترک) وهو اللفظ الذی تعدد معناه وقد وضع للجمیع کلا على حدة، ولکن من دون أن یسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر مثل (عین) الموضوع لحاسة النظر وینبوع الماء والذهب وغیرها ومثل (الجون) الموضوع للأسود والأبیض. والمشترک کثیر فی اللغة العربیة.
3 - (المنقول) وهو اللفظ الذی تعدد معناه وقد وضع للجمیع کالمشترک ولکن یفترق عنه بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظة المناسبة بین المعنیین فی الوضع اللاحق. مثل لفظ (الصلاة) الموضوع أولاً للدعاء ثم نقل فی الشرع الإسلامی لهذه الأفعال المخصوصة من قیام ورکوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأول. ومثل لفظ (الحج) الموضوع أولاً للقصد مطلقاً، ثم نقل لقصد مکة المکرمة بالأفعال المخصوصة والوقت المعین... وهکذا أکثر المنقولات فی عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون. ومنها لفظ السیارة والطائرة والهاتف والمذیاع ونحوها من مصطلحات هذا العصر.
والمنقول ینسب إلى ناقله فإن کان العرف العام قیل له: منقول عرفی کلفظ السیارة والطائرة. وإن کان العرف الخاص کعرف أهل الشرع والمناطقة والنحاة والفلاسفة ونحوهم قیل له: منقول شرعی أو منطقی أو نحوی أو فلسفی... وهکذا.
4 - (المرتجل) وهو کالمنقول بلا فرق إلا أنه لم تلحظ فیه المناسبة بین المعنیین، ومنه أکثر الأعلام الشخصیة.
5 - (الحقیقة والمجاز) وهو اللفظ الذی تعدد معناه، ولکنه موضوع لأحد المعانی فقط، واستعمل فی غیره لعلاقة ومناسبة بینه وبین المعنى الأول الموضوع له من دون أن یبلغ حد الوضع فی المعنى الثانی فیسمى (حقیقة) فی المعنى الأول، و(مجازاً) فی الثانی، ویقال للمعنى الأول معنى حقیقی، وللثانی مجازی.
والمجاز دائماً یحتاج إلى قرینة تصرف اللفظ عن المعنى الحقیقی وتعین المعنى المجازی من بین المعانی المجازیة.
تنبیهان:
1 - إن المشترک اللفظی والمجاز لا یصح استعمالهما فی الحدود والبراهین، إلا مع نصب القرینة على إرادة المعنى المقصود، ومثلهما المنقول والمرتجل ما لم یهجر المعنى الأول، فإذا هجر کان ذلک وحده قرینة على إرادة الثانی.
على أنه یحسن اجتناب المجاز فی الأسالیب العلمیة حتى مع القرینة.
2 – المنقول ینقسم إلى (تعیینی وتعیّنی) لأن النقل تارة یکون من ناقل معین باختیاره وقصده، کأکثر المنقولات فی العلوم والفنون وهو المنقول (التعیینی) أی أن الوضع فیه بتعیین معین. وأخرى لا یکون بنقل ناقل معین باختیاره، وإنما یستعمل جماعة من الناس اللفظ فی غیر معناه الحقیقی لا بقصد الوضع له، ثم یکثر استعمالهم له ویشتهر بینهم، حتى یتغلب المعنى المجازی على اللفظ فی أذهانهم فیکون کالمعنى الحقیقی یفهمه السامع منهم بدون القرینة. فیحصل الارتباط الذهنی بین نفس اللفظ والمعنى، فینقلب اللفظ حقیقة فی هذا المعنى. وهو (المنقول التعینی).
الترادف و التباین
إذا قسنا لفظاً إلى لفظ أو إلى ألفاظ، فلا تخرج تلک الألفاظ المتعددة عن أحد قسمین:
1- إما أن تکون موضوعة لمعنى واحد، فهی (المترادفة)، إذا کان أحد الألفاظ ردیفاً للآخر على معنى واحد. مثل: أسد وسبع ولیث. هرة وقطة. إنسان وبشر.
فالترادف: «اشتراک الألفاظ المتعددة فی معنى واحد».
2- وإما أن یکون کل واحد منها موضوعاً لمعنى مختص به، فهی (المتباینة)، مثل: کتاب. قلم. سماء. أرض. حیوان. جماد. سیف. صارم.. .
فالتباین: «أن تکون معانی الألفاظ متکثرة بتکثر الألفاظ». والمراد من التباین هنا غیر التباین الذی سیأتی فی النسب، فإن التباین هنا بین الألفاظ باعتبار تعدد معناها، وإن کانت المعانی تلتقی فی بعض أفرادها أو جمیعها، فإن السیف یباین الصارم، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السیوف. فهما متباینان معنى وإن کانا یلتقیان فی الأفراد، إذ أن الصارم سیف. وکذا الإنسان والناطق، متباینان معنى، لأن المفهوم من أحدهما غیر المفهوم من الآخر وإن کانا یلتقیان فی جمیع أفرادهما لأن کل ناطق إنسان وکل إنسان ناطق.
قسمه الالفاظ المتباینه
المثلان. المتخالفان. المتقابلان:
تقدم أن الألفاظ المتباینة هی ما تکثرت معانیها بتکثرها، أی أن معانیها متغایرة. ولما کان التغایر بین المعانی یقع على أقسام، فإن الألفاظ بحسب معانیها أیضاً تنسب لها تلک الأقسام. والتغایر على ثلاثة أنواع: التماثل، والتخالف، والتقابل.
لأن المتغایرین إما أن یراعى فیهما اشتراکهما فی حقیقة واحدة فهما (المثلان) وإما ألا یراعى ذلک سواء کانا مشترکین بالفعل فی حقیقة واحدة أو لم یکونا. وعلى هذا التقدیر الثانی أی تقدیر عدم المراعاة، فإن کانا من المعانی التی لا یمکن اجتماعهما فی محل واحد من جهة واحدة فی زمان واحد، بأن کان بینهما تنافر وتعاند فهما (المتقابلان)، وإلا فهما (المتخالفان).
وهذا یحتاج إلى شیء من التوضیح، فنقول:
1- (المثلان) هما المشترکان فی حقیقة واحدة بما هما مشترکان، أی لوحظ واعتبر اشتراکهما فیها، کمحمد وجعفر اسمین لشخصین مشترکین فی اﻹنسانیة بما هما مشترکان فیها. وکالإنسان والفرس باعتبار اشتراکهما فی الحیوانیة. وإلا فمحمد وجعفر من حیث خصوصیة ذاتیهما مع قطع النظر عما اشترکا فیه هما متخالفان کما سیأتی. وکذا الإنسان والفرس هما متخالفان بما هما إنسان وفرس.
والاشتراک والتماثل إن کان فی حقیقة نوعیة بأن یکونا فردین من نوع واحد کمحمد وجعفر یخص باسم المثلین أو المتماثلین ولا اسم آخر لهما. وإن کان فی الجنس کالإنسان والفرس سمّیا أیضاً (متجانسین) وإن کان فی الکم أی فی المقدار سمّیا أیضاً (متساویین)، وإن کان فی الکیف أی فی کیفیتهما وهیئتهما سمّیا أیضاً (متشابهین). والاسم العام للجمیع هو (التماثل).
والمثلان أبداً لا یجتمعان ببدیهة العقل.
2- (المتخالفان) وهما المتغایران من حیث هما متغایران، ولا مانع من اجتماعهما فی محل واحد إذا کانا من الصفات، مثل الإنسان والفرس بما هما إنسان وفرس، لا بما هما مشترکان فی الحیوانیة کما تقدم. کذلک: الماء والهواء، النار والتراب، الشمس والقمر، السماء والأرض.
ومثل السواد والحلاوة، الطول والرقة، الشجاعة والکرم، البیاض والحرارة. والتخالف قد یکون فی الشخص مثل محمد وجعفر وإن کانا مشترکین نوعاً فی الإنسانیة، ولکن لم یلحظ هذا الاشتراک. وقد یکون فی النوع مثل الإنسان والفرس وإن کانا مشترکین فی الجنس وهو الحیوان ولکن لم یلحظ الاشتراک. وقد یکون فی الجنس، وإن کانا مشترکین فی وصفهما العارض علیهما، مثل القطن والثلج المشترکین فی وصف الأبیض إلاّ أنه لم یلحظ ذلک.
ومنه یظهر أن مثل محمد وجعفر یصدق علیهما أنهما متخالفان بالنظر إلى اختلافهما فی شخصیهما ویصدق علیهما مثلان بالنظر إلى اشتراکهما وتماثلهما فی النوع وهو الإنسان. وکذا یقال عن الإنسان والفرس هما متخالفان من جهة تغایرهما فی الإنسانیة والفرسیة ومثلان باعتبار اشتراکهما فی الحیوانیة. وهکذا فی مثل القطن والثلج. الحیوان والنبات. الشجر والحجر.
ویظهر أیضاً أن التخالف لا یختص بالشیئین اللذین یمکن أن یجتمعا، فإن الأمثلة المذکورة قریباً لا یمکن فیها الاجتماع مع أنها لیست من المتقابلات - کما سیأتی - ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح.
ثم إن التخالف قد یطلق على ما یقابل التماثل فیشمل التقابل أیضاً فیقال للمتقابلین على هذا الاصطلاح أنهما متخالفان.
3- (المتقابلان) هما المعنیان المتنافران اللذان لا یجتمعان فی محل واحد من جهة واحدة فی زمان واحد، کالإنسان واللاإنسان. والأعمى والبصیر، والأبوة والبنوة، والسواد والبیاض.
فبقید وحدة المحل دخل مثل التقابل بین السواد والبیاض مما یمکن اجتماعهما فی الوجود کبیاض القرطاس وسواد الحبر. وبقید وحدة الجهة دخل مثل التقابل بین الأبوة والبنوة مما یمکن اجتماعهما فی محل واحد من جهتین إذ قد یکون شخص أباً لشخص وابناً لشخص آخر. وبقید وحدة الزمن دخل مثل التقابل بین الحرارة والبرودة مما یمکن اجتماعهما فی محل واحد فی زمانین، إذ قد یکون جسم بارداً فی زمان ونفسه حاراً فی زمان آخر.
اقسام التقابل
للتقابل أربعة أقسام:
1- (تقابل النقیضین) أو السلب والإیجاب، مثل: إنسان ولا إنسان، سواد ولا سواد، منیر وغیر منیر. والنقیضان: أمران وجودی وعدمی، أی عدم لذلک الوجودی، وهما لا یجتمعان ولا یرتفعان ببدیهة العقل، ولا واسطة بینهما.
2- (تقابل الملکة وعدمها) کالبصر والعمى، الزواج والعزوبة، فالبصر ملکة والعمى عدمها. والزواج ملکة والعزوبة عدمها.
ولا یصح أن یحل العمى إلاّ فی موضع یصح فیه البصر، لأن العمى لیس هو عدم البصر مطلقاً، بل عدم البصر الخاص، وهو عدمه فیمن شأنه أن یکون بصیراً. وکذا العزوبة لا تقال إلاّ فی موضع یصح فیه الزواج، لا عدم الزواج مطلقاً، فهما لیسا کالنقیضین لا یرتفعان ولا یجتمعان، بل هما یرتفعان. وإن کان یمتنع اجتماعهما، فالحجر لا یقال فیه أعمى ولا بصیر، ولا أعزب ولا متزوج، لأن الحجر لیس من شأنه أن یکون بصیراً، ولا من شأنه أن یکون متزوجاً.
إذن الملکة وعدمها: «أمران وجودی وعدمی لا یجتمعان ویجوز أن یرتفعا فی موضع لا تصح فیه الملکة».
3- (تقابل الضدین) کالحرارة والبرودة، والسواد والبیاض، والفضیلة والرذیلة، والتهور والجبن، والخفة والثقل.
والضدان: «هما الوجودیان المتعاقبان على موضع واحد، ولا یتصور اجتماعهما فیه، ولا یتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر».
وفی کلمة (المتعاقبان على موضوع واحد) یفهم أن الضدین لابد أن یکونا صفتین، فالذاتان مثل إنسان وفرس لا یسمیان بالضدین. وکذا الحیوان والحجر ونحوهما. بل مثل هذه تدخل فی المعانی المتخالفة، کما تقدم.
وبکلمة «لا یتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر» یخرج المتضایفان، لأنهما أمران وجودیان أیضاً ولا یتصور اجتماعهما فیه من جهة واحدة، ولکن تعقل أحدهما یتوقف على تعقل الآخر. وسیأتی.
4- (تقابل المتضایفین) مثل: الأب والابن، الفوق والتحت، المتقدم والمتأخر، العلّة والمعلول، الخالق والمخلوق وأنت إذا لاحظت هذه الأمثلة تجد:
(أولاً) أنک إذا تعقلت أحد المتقابلین منها لابد أن تتعقل معه مقابله الآخر: فإذا تعقلت أن هذا أب أو علّة لابدّ أن تتعقل معه أن له ابناً أو معلولاً.
(ثانیاً) أن شیئاً واحداً لا یصح أن یکون موضوعاً للمتضایفین من جهة واحدة، فلا یصح أن یکون شخص أباً وابناً لشخص واحد، نعم یکون أباً لشخص وابناً لشخص آخر. وکذا لا یصح أن یکون الشیء فوقاً وتحتاً لنفس ذلک الشیء فی وقت واحد. وإنما یکون فوقاً لشیء هو تحت له، وتحتاً لشیء آخر هو فوقه...
وهکذا. (ثالثاً) أن المتقابلین فی بعض هذه الأمثلة المذکورة أولاً، یجوز أن یرتفعا، فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت، والحجر لا أب ولا ابن. وإذا اتفق فی بعض الأمثلة أن المتضایفین لا یرتفعان کالعلّة والمعلول، فلیس ذلک لأنهما متضایفان. بل لأمر یخصهما، لأن کل شیء موجود لا یخلو إما أن یکون علّة أو یکون معلولاً.
وعلى هذا البیان یصح تعریف المتضایفین بأنهما:
«الوجودیان اللذان یتعقلان معاً ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جهة واحدة ویجوز أن یرتفعا».
المفرد و المرکب
ینقسم اللفظ مطلقاً (غیر معتبر فیه أن یکون واحداً أو متعدداً) إلى قسمین:
أ- (المفرد) ویقصد المنطقیون به:
(أولاً) اللفظ الذی لا جزء له، مثل الباء من قولک: کتبت بالقلم، و(قِ) فعل أمر من وقى یقی.
(ثانیاً) اللفظ الذی له جزء إلا أن جزء اللفظ لا یدل على جزء المعنى حین هو جزء له، مثل: محمد. علی. قرأ. عبدالله. عبدالحسین. وهذان الأخیران إذا کانا اسمین لشخصین فأنت لا تقصد بجزء اللفظ (عبد) و(الله) و(الحسین) معنى أصلاً، حینما تجعل مجموع الجزأین دالاً على ذات الشخص. وما مثَل هذا الجزء إلا کحرف (م) من محمد وحرف (ق) من قرأ.
نعم فی موضع آخر قد تقول (عبدالله) وتعنی بعبد معناه المضاف إلى الله تعالى کما تقول (محمد عبدالله ورسوله). وحینئذ یکون نعتاً لا اسماً ومرکباً لا مفرداً. أما لو قلت (محمد بن عبدالله) فعبدالله مفرد هو اسم أب محمد.
أما النحویون فعندهم مثل (عبدالله) إذا کان اسماً لشخص مرکب لا مفرد، لأن الجهة المعتبرة لهم فی هذه التسمیة تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطقة. إذ النحوی ینظر إلى الإعراب والبناء، فما کان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد وإلا فمرکب کعبدالله علماً فإن (عبدالله) له إعراب و(الله) له إعراب. أما المنطقی فإنما ینظر المعنى فقط.
إذن المفرد عند المنطقی هو:
«اللفظ الذی لیس له جزء یدل على جزء معناه حین هو جزء».
ب - (المرکب) ویسمى القول. وهو اللفظ الذی له جزء یدل على جزء معناه حین هو جزء مثل (الخمر مضر)، فالجزءان: (الخمر)، و(مضر) یدلّ کل منهما على جزء معنى المرکب. ومنه (الغیبة جهد العاجز) فالمجموع مرکب و(جهد العاجز) مرکب أیضاً. ومنه (شر الإخوان من تکلّف له) فالمجموع مرکب، و(شر الإخوان) مرکب أیضاً، و(من تکلّف له) مرکب أیضاً.. .
اقسام المرکب
المرکب: تام وناقص. التام: خبر وإنشاء.
أ- التام والناقص:
1- بعض المرکبات للمتکلم أن یکتفی به فی إفادة السامع، والسامع لا ینتظر منه إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته. مثل الصبر شجاعة. قیمة کل امرئ ما یحسنه. إذا علمت فاعمل - فهذا هو (المرکب التام). ویعرَّف بأنه: «ما یصح للمتکلّم السکوت علیه».
2- أما إذا قال: (قیمة کل امرئ.. .) وسکت، أو قال: (إذا علمت.. .) بغیر جواب للشرط، إن السامع یبقى منتظراً ویجده ناقصاً، حتى یتم کلامه. فمثل هذا یسمى (المرکب الناقص). ویعرف بأنه: «ما لا یصح السکوت علیه».
ب - الخبر والإنشاء:
کل مرکب تام له نسبة قائمة بین أجزائه تسمى النسبة التامة أیضاً، وهذه النسبة:
1- قد تکون لها حقیقة ثابتة فی ذاتها، مع غض النظر عن اللفظ. وإنما یکون اللفظ المرکب حاکیاً وکاشفاً عنها. مثلما إذا وقع حادث أو یقع فیما یأتی، فأخبرت عنه، کمطر السماء، فقلت: مطرت السماء، أو تمطر غداً. فهذا یسمى (الخبر) ویسمى أیضاً (القضیة) و (القول). ولا یجب فی الخبر أن یکون مطابقاً للنسبة الواقعة: فقد یطابقها فیکون صادقاً، وقد لا یطابقها فیکون کاذباً.
إذن الخبر هو: «المرکب التام الذی یصح أن نصفه بالصدق أو الکذب». والخبر هو الذی یهم المنطقی أن یبحث عنه، وهو متعلق التصدیق.
2- وقد لا تکون للنسبة التامة حقیقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ، وإنما اللفظ هو الذی یحقق النسبة ویوجدها بقصد المتکلم، وبعبارة أصرح إن المتکلم یوجد المعنى بلفظ المرکب، فلیس وراء الکلام نسبة لها حقیقة ثابتة یطابقها الکلام تارة ولا یطابقها أخرى. ویسمى هذا المرکب (الإنشاء). ومن أمثلته:
1- (الأمر) نحو: احفظ الدرس.
2- (النهی) نحو: لا تجالس دعاة السوء.
3- (الاستفهام) نحو: هل المریخ مسکون؟
4- (النداء) نحو: یا محمد!
5- (التمنی) نحو: لو أن لنا کرة فنکون من المؤمنین!
6- (التعجب) نحو: ما أعظم خطر الإنسان!
7- (العقد): کإنشاء عقد البیع والإجارة والنکاح ونحوها نحو بعت وآجرت وأنکحت... .
8- (الإیقاع): کصیغة الطلاق والعتق والوقف ونحوها نحو فلانة طالق. وعبدی حر...
وهذه المرکبات کلها لیس لمعانیها حقائق ثابتة فی نفسها - بغض النظر عن اللفظ - تحکی عنها فتطابقها أو لا تطابقها، وإنما معانیها تنشأ وتوجد باللفظ، فلا یصح وصفها بالصدق والکذب.
فالإنشاء هو: «المرکب التام الذی لا یصح أن نصفه بصدق وکذب».
اقسام المفرد
المفرد: کلمة - اسم - أداة.
1- (الکلمة) وهی الفعل باصطلاح النحاة. مثل: کتب. یکتب. اکتب. فإذا لاحظنا هذه الأفعال أو الکلمات الثلاث نجدها:
(أولاً) تشترک فی مادة لفظیة واحدة محفوظة فی الجمیع هی (الکاف فالتاء فالباء). وتشترک أیضاً فی معنى واحد هو معنى الکتابة، وهو معنى مستقل فی نفسه.
و(ثانیاً) تفترق فی هیئاتها اللفظیة، فإن لکل منها هیئة تخصها. وتفترق أیضاً فی دلالتها على نسبة تامة زمانیة تختلف باختلافها، وهی نسبة ذلک المعنى المستقل المشترک فیها إلى فاعل ما غیر معین فی زمان معین من الأزمنة. فکتب تدل على نسبة الحدث (وهو المعنى المشترک) إلى فاعل ما، واقعة فی زمان مضى. ویکتب على نسبة تجدد الوقوع فی الحال أو فی الاستقبال إلى فاعلها. واکتب على نسبة طلب الکتابة فی الحال من فاعل ما.
ومن هذا البیان نستطیع أن نستنتج أن المادة التی تشترک فیها الکلمات الثلاث تدل على المعنى الذى تشترک فیه، وأن الهیئة التی تفترق فیها وتختلف تدل على المعنى الذی تفترق فیه ویختلف فیها:
وعلیه یصح تعریف الکلمة بأنها: «اللفظ المفرد الدال بمادته على معنى مستقل فی نفسه وبهیئته على نسبة ذلک المعنى إلى فاعل لا بعینه نسبة تامة زمانیة».
وبقولنا: نسبة تامة تخرج الأسماء المشتقة کاسم الفاعل والمفعول والزمان والمکان، فإنها تدل بمادتها على المعنى المستقل وبهیئاتها على نسبة إلى شیء لا بعینه فی زمان ما، ولکن النسبة فیها نسبة ناقصة لا تامة.
2- (الاسم) وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل فی نفسه غیر مشتمل على هیئة تدل على نسبة تامة زمانیة. مثل: محمد. إنسان. کاتب. سؤال. نعم قد یشتمل على هیئة تدل على نسبة ناقصة کأسماء الفاعل والمفعول والزمان ونحوها کما تقدم، لأنها تدل على ذات لها هذه المادة.
3- (الأداة) وهی الحرف باصطلاح النحاة. وهو یدل على نسبة بین طرفین. مثل: (فی) الدالة على النسبة الظرفیة. و(على) الدالة على النسبة الاستعلائیة. و(هل) الدالة على النسبة الاستفهامیة. والنسبة دائماً غیر مستقلة فی نفسها، لأنها لا تتحقق إلا بطرفیها. فالأداة تعرف بأنها: «اللفظ المفرد الدال على معنى غیر مستقل فی نفسه».
(ملاحظة):
لأفعال الناقصة مثل کان وأخواتها فی عرف المنطقیین - على التحقیق - تدخل فی الأدوات، لأنها لا تدل على معنى مستقل فی نفسها لتجردها عن الدلالة على الحدث، بل إنما تدل على النسبة الزمانیة فقط. فلذلک تحتاج إلى جزء یدل على الحدث، نحو (کان محمد قائماً) فکلمة قائم هی التی تدل علیه.
وفی عرف النحاة معدودة من الأفعال وبعض المناطقة یسمیها (الکلمات الوجودیة).
*الباب الثانی: مباحث الکلی و الجزئی*
یدرک الإنسان مفهوم الموجودات التی یحسّ بها، مثل: محمد. هذا الکتاب. هذا القلم. هذه الوردة. بغداد.
النجف... وإذا تأملها یجد کل واحد منها لا ینطبق على فرد آخر، ولا یصدق إلا على ذلک الموجود وحده. وهذا هو المفهوم (الجزئی). ویصح تعریفه بأنه: «المفهوم الذی یمتنع صدقه على أکثر من واحد». ثم إن الإنسان إذا رأى جزئیات متعددة، وقاس بعضها إلى بعض، فوجدها تشترک فی صفة واحدة انتزع منها صورة مفهوم شامل ینطبق على کل واحد منها. وهذا المفهوم الشامل أو (الصورة المنتزعة) هو المفهوم (الکلی). ویصح تعریفه بأنه «المفهوم الذی لا یمتنع صدقه على أکثر من واحد».
مثل مفهوم: إنسان. حیوان. معدن. أبیض. تفاحة. حجر. عالم. جاهل. جالس فی الدار. معترف بذنبه.
تکملة تعریف الجزئی والکلی:
لا یجب أن تکون أفراد الکلی موجودة فعلاً: فقد یتصور العقل مفهوماً کلیاً صالحاً للانطباق على أکثر من واحد من دون أن ینتزعه من جزئیات موجودة بالفعل، وإنما یفرض له جزئیات یصح صدقه علیها، بل قد یمتنع وجود حتى فرد واحد له مثل مفهوم «شریک الباری»، ومفهوم «اجتماع النقیضین». ولا یضر ذلک فی کلیته. وقد لا یوجد له إلا فرد واحد ویمتنع وجود غیره، مثل مفهوم «واجب الوجود»، لقیام البرهان على ذلک، ولکن العقل لا یمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق علیها هذا المفهوم. ولو کان مفهوم «واجب الوجود» جزئیاً، لما کانت حاجة إلى البرهان على التوحید، وکفى نفس تصور مفهومه لنفی وقوع الشرکة فیه. وعلیه فهذا الانحصار فی فرد واحد إنما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم، لا أن نفس المفهوم یمتنع صدقه على أفراد کثیرة.
إذن، بمقتضى هذا البیان لابد من إضافة قید (ولو بالفرض) فی تعریفی الجزئی والکلی، فالجزئی: «مفهوم یمتنع صدقه على کثیر ولو بالفرض»، والکلی: «لا یمتنع... ولو بالفرض».
(تنبیه):
مدالیل الأدوات کلها مفاهیم جزئیة، والکلمات أی (الأفعال) بهیئاتها تدل على مفاهیم جزئیة، وبموادها على مفاهیم کلیة. أما الأسماء فمدالیلها تختلف، فقد تکون کلیة کأسماء الأجناس، وقد تکون جزئیة کأسماء الأعلام وأسماء الإشارة والضمائر ونحوها.
الجزئی الاضافی
الجزئی الذی تقدم البحث عنه یسمى (الجزئی الحقیقی). وهنا اصطلاح آخر للجزئی یقال له (الجزئی الإضافی) لإضافته إلى ما فوقه، ومع ذلک قد یکون کلیاً إذا کان أضیق دائرة من کلی آخر أوسع منه.
توضیحه: إنک تجد أن (الخط المستقیم) مفهوم کلی منتزع من عدة أفراد کثیرة، وتجد أن (الخط المنحنی) أیضاً مفهوم کلی منتزع من مجموعة أفراد أخرى فإذا ضممنا إحدى المجموعتین إلى الأخرى وألغینا ما بینهما من الفروق، ننتزع مفهوماً کلیاً أکثر سعة من المفهومین الأولین یصدق على جمیع أفرادهما، وهو مفهوم (الخط). فهذا المفهوم الثالث الکبیر نسبته إلى المفهومین الصغیرین، کنسبة کل منهما إلى أفراد نفسه، فکما کان الفرد من الصغیر بالإضافة إلى الصغیر نفسه جزئیاً، فالکلی الصغیر أیضاً بالإضافة إلى الکلی الکبیر کالجزئی من جهة النسبة، فیسمى (جزئیاً إضافیاً) لا بالحقیقة لأنه فی نفسه کلی حقیقة.
وکذا الجزئی الحقیقی من جهة إضافته إلى الکلی الذی فوقه یسمى (جزئیاً إضافیاً).
وهکذا کل مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة یسمى (جزئیاً إضافیاً)، فزید مثلاً جزئی حقیقی فی نفسه وجزئی إضافی بالقیاس إلى الحیوان، وکذا الحیوان بالقیاس إلى الجسم النامی، والجسم النامی بالقیاس إلى مطلق الجسم.
إذن یمکن تعریف الجزئی الإضافی بأنه (الأخص من شیء) أو «المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة»
المتواطئ و المشکک
ینقسم الکلی إلى المتواطئ والمشکک، لأنه:
أولاً: إذا لاحظت کلیاً مثل الإنسان والحیوان والذهب والفضة، وطبقته على أفراده، فإنک لا تجد تفاوتاً بین الأفراد فی نفس صدق المفهوم علیه: فزید وعمرو وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحیة الإنسانیة سواء، من دون أن تکون إنسانیة أحدهم أولى من إنسانیة الآخر ولا أشد ولا أکثر، ولا أی تفاوت آخر فی هذه الناحیة. وإذا کانوا متفاوتین ففی نواحٍ أخرى غیر الإنسانیة، کالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والإخلاص وحسن التفکیر... وما إلى ذلک. وکذا أفراد الحیوان والذهب، ونحوهما، ومثل هذا الکلی المتوافقة أفراده فی مفهومه یسمى (الکلی المتواطئ) أی المتوافقة أفراده فیه، والتواطؤ: هو التوافق والتساوی.
ثانیاً: إذا لاحظت کلیاً مثل مفهوم البیاض والعدد والوجود، وطبقته على أفراده، تجد - على العکس من النوع السابق، تفاوتاً بین الأفراد فی صدق المفهوم علیها، بالاشتداد أو الکثرة أو الأولویة أو التقدم. نرى بیاض الثلج أشد بیاضاً من بیاض القرطاس، وکل منهما بیاض. وعدد الألف أکثر من عدد المائة، وکل منهما عدد. ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق، ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشیء آخر، وکل منهما وجود. وهکذا الکلی المتفاوتة أفراده فی صدق مفهومه علیها یسمى (الکلی المشکک) والتفاوت یسمى (تشکیکاً).
المفهوم و المصداق
(المفهوم) نفس المعنى بما هو، أی نفس الصورة الذهنیة المنتزعة من حقائق الأشیاء.
و(المصداق) ما ینطبق علیه المفهوم، أو حقیقة الشیء الذی تنتزع منه الصورة الذهنیة (المفهوم).
فالصورة الذهنیة لمسمى (محمد) مفهوم جزئی، والشخص الخارجی الحقیقی مصداقه. والصورة الذهنیة لمعنى (الحیوان) مفهوم کلی، وأفراده الموجودة وما یدخل تحته من الکلیات کالإنسان والفرس والطیر مصادیقه. والصورة الذهنیة لمعنى (العدم) مفهوم کلی، وما ینطبق علیه وهو العدم الحقیقی مصداقه... وهکذا.
(لفت نظر):
یعرف من المثال الأول أن المفهوم قد یکون جزئیاً کما یکون کلیاً. ویعرف من المثال الثانی أن المصداق یکون جزئیاً حقیقیاً وإضافیاً. ویعرف من الثالث أن المصداق لا یجب أن یکون الأمور الموجودة والحقائق العینیة، بل المصداق هو کل ما ینطبق علیه المفهوم وإن کان أمراً عدمیاً لا تحقق له فی الأعیان.
***
العنوان و المعنون
إذا حکمت على شیء بحکم قد یکون نظرک فی الحکم مقصوراً على المفهوم وحده، بأن یکون هو المقصود فی الحکم، کما تقول: (الإنسان: حیوان ناطق) فیقال للإنسان حینئذ الإنسان بالحمل الأولی.
وقد یتعدى نظرک فی الحکم إلى أبعد من ذلک، فتنظر إلى ما وراء المفهوم، بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاکیاً عن مصداقه ودلیلاً علیه، کما تقول: (الإنسان ضاحک) أو (الإنسان فی خسر)، فتشیر بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده وهی المقصودة فی الحکم، ولیس ملاحظة المفهوم فی الحکم وجعله موضوعاً إلاّ للتوصل إلى الحکم على الأفراد. فیسمى المفهوم حینئذٍ (عنواناً) والمصداق (معنوناً). ویقال لهذا الإنسان: الإنسان بالحمل الشایع.
ولأجل التفرقة بین النظرین نلاحظ الأمثلة الآتیة:
1- إذا قال النحاة: «الفعل لا یخبر عنه». فقد یعترض علیهم فی بادی الأمر، فیقال لهم: هذا القول منکم إخبار عن الفعل، فکیف تقولون لا یخبر عنه؟ والجواب: أن الذی وقع فی القضیة مخبراً عنه، وموضوعاً فی القضیة هو مفهوم الفعل، ولکن لیس الحکم له بما هو مفهوم، بل جعل عنواناً وحاکیاً عن مصادیقه وآلة لملاحظتها، والحکم فی الحقیقة راجع للمصادیق نحو ضرب ویضرب. فالفعل الذی له هذا الحکم حقیقة هو الفعل بالحمل الشایع.
2 - وإذا قال المنطقی: ` الجزئی یمتنع صدقه على کثیرین ` فقد یعترض فیقال له: الجزئی یصدق على کثیرین، لأن هذا الکتاب جزئی، ومحمد جزئی وعلی جزئی، ومکة جزئی، فکیف قلتم یمتنع صدقه على کثیرین؟
والجواب: مفهوم الجزئی - أی الجزئی بالحمل الأولی - کلی، لا جزئی، فیصدق على کثیرین، ولکن مصداقه - أی حقیقة الجزئی - یمتنع صدقه على الکثیر، فهذا الحکم بالامتناع للجزئی بالحمل الشایع، لا للجزئی بالحمل الأولی الذی هو کلی.
٣ - وإذا قال الأصولی: ` اللفظ المجمل ما کان غیر ظاهر المعنى ` فقد یعترض فی بادئ الرأی فیقال له: إذا کان المجمل غیر ظاهر المعنى فکیف جاز تعریفه والتعریف لا یکون إلا لما کان ظاهرا معناه؟ والجواب: مفهوم المجمل - أی المجمل بالحمل الأولی - مبین ظاهر المعنى، لکن مصداقه - أی المجمل بالحمل الشایع کاللفظ المشترک المجرد عن القرینة - غیر ظاهر المعنى، وهذا التعریف للمجمل بالحمل الشایع.
***
النسب الاربع
تقدم فی الباب الأول انقسام الألفاظ إلى مترادفة ومتباینة. والمقصود بالتباین هناک التباین بحسب المفهوم أی أن معانیها متغایرة. وهنا سنذکر أن من جملة النسب التباین والمقصود به التباین بحسب المصداق.
فما کنا نصطلح علیه هناک بالمتباینة، هنا نقسم النسبة بینها إلى أربعة أقسام، وقسم منها المتباینة، لاختلاف الجهة المقصودة فی البحثین، فإنا کنا نتکلم هناک عن تقسیم الألفاظ بالقیاس إلى تعدد المعنى واتحاده.
أما هنا فالکلام عن النسبة بین المعانی باعتبار اجتماعها فی المصداق وعدمه. ولا یتصور هذا البحث إلا بین المعانی المتغایرة أی المعانی المتباینة بحسب المفهوم، إذ لا یتصور فرض النسبة بین المفهوم ونفسه، فنقول:
کل معنى إذا نسب إلى معنى آخر یغایره ویباینه مفهوماً فإما أن یشارک کل منهما الآخر فی تمام أفرادهما. وإما أن یشارک کل منهما الآخر فی بعض أفراده، وهما اللذان بینهما نسبة العموم والخصوص من وجه، وإما أن یشارک أحدهما الآخر فی جمیع أفراده دون العکس، وهما اللذان بینهما نسبة العموم والخصوص مطلقاً. وإما أن لا یشارک أحدهما الآخر أبداً، وهما المتباینان.
فالنسب بین المفاہیم اربع ،التساوی۔۔۔
الکلیات الخمسه
الکلی: ذاتی وعرضی.
الذاتی: نوع وجنس وفصل.
العرضی: خاصة وعرض عام.
• قد یسأل سائل عن شخص إنسان (من هو؟). • وقد یسأل عنه..... (ما هو؟).
فهل تجد فرقاً بین السؤالین؟ ـ لا شک أن الأول سؤال عن ممیزاته الشخصیة. والجواب عنه: (ابن فلان) أو مؤلف کتاب کذا، أو صاحب العمل الکذائی، أو ذو الصفة الکذائیة... وأمثال ذلک من الأجوبة المقصود بها تعیین المسؤول عنه من بین الأشخاص أمثاله. ویغلط المجیب لو قال: (إنسان) لأنه لا یمیزه عن أمثاله من أفراد الإنسان. ویصطلح فی هذا العصر على الجواب عن هذا السؤال بـ (الهویة الشخصیة) مأخوذة من کلمة (هو) کالمعلومات التی تسجل عن الشخص فی دفتر النفوس.
أما السؤال الثانی، فإنما یسأل به عن حقیقة الشخص التی یتفق بها مع الأشخاص الآخرین أمثاله، والمقصود بالسؤال تعیین تمام حقیقته بین الحقائق لا شخصه بین الأشخاص. ولا یصلح للجواب إلا کمال حقیقته فتقول: (إنسان) دون ابن فلان ونحوه. ویسمى الجواب عن هذا السؤال:
النوع:
وهو أول الکلیات الخمسة وسیأتی قریباً تعریفه.
• وقد یسأل السائل عن زید وعمرو وخالد..... (ما هی؟).
• وقد یسأل السائل عن زید وعمرو وخالد وهذه الفرس وهذا الأسد (ما هی).
هل تجد فرقاً بین السؤالین؟ ـ تأمل فیهما، فستجد أن (الأول) سؤال عن حقیقة جزئیات متفقة بالحقیقة مختلفة بالعدد. و(الثانی) سؤال عن حقیقة جزئیات مختلفة بالحقیقة والعدد.
والجواب عن الأول بکمال الحقیقة المشترکة بینهما، فتقول: إنسان. وهو (النوع) المتقدم ذکره.
وعن الثانی أیضاً بکمال الحقیقة المشترکة بینها، فتقول: حیوان ویسمى:
الجنس:
وهو ثانی الکلیات الخمسة. وعلیه یمکن تعریفهما بما یأتی:
1- (النوع) هو تمام الحقیقة المشترکة بین الجزئیات المتکثرة بالعدد فقط فی جواب ما هو؟
2- (الجنس) هو تمام الحقیقة المشترکة بین الجزئیات المتکثرة بالحقیقة فی جواب ما هو؟ ـ وإذا تکثرت الجزئیات بالحقیقة فلابد أن تتکثر بالعدد قطعاً.
• وقد یسأل السائل عن الإنسان والفرس..... والقرد (ما هی؟)
• وقد یسأل السائل عن الإنسان فقط..... (ما هو؟) لاحظ أن (الکلیات) هی المسؤول عنها هذه المرة! فماذا ترى ینبغی أن یکون الجواب عن کل من السؤالین؟ ـ نقول: أما الأول فهو سؤال عن کلیات مختلفة الحقائق، فیجاب عنه بتمام الحقیقة المشترکة بینها. وهو الجنس. فتقول فی المثال: (حیوان). ومنه یعرف أن الجنس یقع أیضاً جواباً عن السؤال بما هو عن الکلیات المختلفة بالحقائق التی تکون أنواعاً له، کما یقع جواباً عن السؤال بما هو عن الجزئیات المختلفة بالحقائق.
وأما الثانی. فهو سؤال بما هو عن کلی واحد. وحق الجواب الصحیح الکامل نقول فی المثال: (حیوان ناطق) فیتکفل الجواب بتفصیل ماهیة الکلی المسؤول عنه وتحلیلها إلى تمام الحقیقة التی یشارکه فیها غیره وإلى الخصوصیة التی بها یمتاز عن مشارکاته فی تلک الحقیقة. ویسمى مجموع الجواب (الحد التام) کما سیأتی فی محله. وتمام الحقیقة المشترکة التی هی الجزء الأول من الجواب هی (الجنس) وقد تقدم. والخصوصیة الممیزة التی هی الجزء الثانی من الجواب هی:
الفصل:
وهو ثالث الکلیات. ومن هذا یتضح أن الفصل جزء من مفهوم الماهیة، ولکنه الجزء المختص بها الذی یمیزها عن جمیع ما عداها، کما أن الجنس جزؤها المشترک الذی أیضاً یکون جزءاً للماهیات الأخرى.
ویبقى شیء ینبغی ذکره، وهو أنا کیف نسأل لیقع الفصل وحده جواباً؟ وبعبارة أوضح: «إن الفصل وحده یقع فی الجواب عن أی سؤال».
نقول: یقع الفصل جواباً عما إذا سألنا عن خصوصیة الماهیة التی بها تمتاز عن أغیارها، بعد أن نعرف تمام الحقیقة المشترکة بینها وبین أغیارها. فإذا رأینا شبحاً من بعید وعرفنا أنه حیوان وجهلنا خصوصیته بطبیعتنا نسأل فنقول: (أی حیوان هو فی ذاته). وإن شئت قلت بدل فی ذاته: فی جوهره أو حقیقته، فإن المعنى واحد. والجواب عن الأول (ناطق) فقط وهو فصل الإنسان أو (صاهل) وهو فصل الفرس. وعن الثانی (حساس) مثلاً وهو فصل الحیوان.
إذن یصح أن نقول أن الفصل یقع فی جواب (أی شیء). وشیء کنایة عن الجنس الذی عرف قبل السؤال عن الفصل. وعلیه یصح تعریف الفصل بما یأتی:
«هو جزء الماهیة المختص بها الواقع فی جواب أی شیء هو فی ذاته».
تقسیمات:
(1) النوع: حقیقی وإضافی.
(2) الجنس: قریب وبعید ومتوسط.
(3) النوع الإضافی: عال وسافل ومتوسط.
(4) الفصل: قریب وبعید. مقوِّم ومقسِّم.
(1) لفظ النوع مشترک بین معنیین أحدهما (الحقیقی)، وهو أحد الکلیات الخمسة، وقد تقدم.
وثانیهما (الإضافی). والمقصود به الکلی الذی فوقه جنس. فهو نوع بالإضافة إلى الجنس الذی فوقه سواء کان نوعاً حقیقیاً أو لم یکن، کالإنسان بالإضافة إلى جنسه وهو الحیوان، وکالحیوان بالإضافة إلى جنسه وهو الجسم النامی، وکالجسم النامی بالإضافة إلى الجسم المطلق، وکالجسم المطلق بالإضافة إلى الجوهر.
(2) قد تتألف سلسلة من الکلیات یندرج بعضها تحت بعض، کالسلسلة المتقدمة التی تبتدئ بالإنسان وتنتهی بالجوهر. فإذا ذهبت بها (متصاعداً) من الإنسان، فمبدؤها (النوع) وهو الإنسان فی المثال، وبعده الجنس الأدنى الذی هو مبدأ سلسلة الأجناس، ویسمى (الجنس القریب) لأنه أقربها إلى النوع. ویسمى أیضاً (الجنس السافل). وهو الحیوان فی المثال.
ثم هذا الجنس فوقه جنس أعلى... حتى تنتهی إلى الجنس الذی لیس فوقه جنس. ویسمى (الجنس البعید) و (الجنس العالی) و (الجنس المتوسط). ویسمى (بعیداً) أیضاً کالجسم المطلق والجسم النامی. فالجنس ـ على هذا ـ قریب وبعید ومتوسط أو سافل وعال ومتوسط.
(3) وإذا ذهبت فی السلسلة متنازلاً مبتدئاً من جنس الأجناس إلى ما دونه، حتى تنتهی إلى النوع الذی لیس تحته نوع. فما کان بعد جنس الأجناس یسمى (النوع العالی) وهو مبدأ سلسلة الأنواع الإضافیة، وهو الجسم المطلق فی المثال. وأخیرها أی منتهى السلسلة یسمى (نوع الأنواع) أو (النوع السافل) وهو الإنسان فی المثال. أما ما یقع بین العالی والسافل فهو (المتوسط) کالحیوان والجسم النامی. فالجسم النامی جنس متوسط ونوع متوسط.
إذن النوع الإضافی: عال ومتوسط وسافل.
(تنبیه):
یتضح مما سبق أن کلا من المتوسطات لابد أن یکون نوعاً لما فوقه وجنساً لما تحته. والمتوسط النوع والجنس قد یکون واحداً إذا تألفت سلسلة الکلیات من أربعة، وقد یکون أکثر إذا کانت السلسلة أکثر من أربعة. فمثال الأول: (الماء) المندرج تحت (السائل) المندرج تحت (الجسم) المندرج تحت (الجوهر). أو (البیاض) المندرج تحت (اللون) المندرج تحت (الکیف المحسوس) المندرج تحت (الکیف).
ومثال الثانی: سلسلة الإنسان إلى الجوهر المؤلفة من خمسة کلیات کما تقدم، أو (متساوی الساقین) المندرج تحت (المثلث) المندرج تحت (الشکل المستقیم الأضلاع) المندرج تحت (الشکل المستوی) المندرج تحت (الشکل) المندرج تحت (الکم). وهذه السلسلة مؤلفة من ستة کلیات، والأنواع المتوسطة ثلاثة (المثلث، والشکل المستقیم الأضلاع، والشکل المستوی). والأجناس المتوسطة ثلاثة أیضاً (الشکل المستقیم الأضلاع، والشکل المستوی، والشکل).
(4) وکل نوع إضافی لابد له من فصل یکون جزءاً من ماهیته یقومها ویمیزها عن الأنواع الأخر التی فی عرضه المشترکة معه فی الجنس الذی فوقه، کما یقسم الجنس إلى قسمین أحدهما نوع ذلک الفصل وثانیهما ما عداه، کالحساس المقوم للحیوان والمقسم للجسم النامی إلى حیوان وغیر حیوان فیقال: الجسم النامی حساس وغیر حساس.
ولکن الفصل الذی یقوِّم نوعه المساوی له لابد أن یقوِّم أیضاً ما تحته من الأنواع. فالحساس المقوم للحیوان یقوم الإنسان وغیره من أنواع الحیوان أیضاً. لأن الفصل المقوم للعالی لابد أن یکون جزءاً من العالی، والعالی جزء من السافل، وجزء الجزء جزء. فیکون الفصل المقوم للعالی جزءاً من السافل، فیقومه.
والقاعدة أیضاً إذا لوحظ بالقیاس إلى نوعه المساوی له قیل له (الفصل القریب) کالحساس بالقیاس إلى الحیوان، والناطق بالقیاس إلى الإنسان. وإذا لوحظ بالقیاس إلى النوع الذی تحت نوعه قیل له (الفصل البعید) کالحساس بالقیاس إلى الإنسان.
والخلاصة: إن الفصل الواحد یسمى قریباً وبعیداً باعتبارین. ویسمى مقوماً ومقسماً باعتبارین.
الذاتی والعرضی:
للذاتی والعرضی اصطلاحات فی المنطق تختلف معانیها. ولا یهمنا الآن التعرض إلا لاصطلاحهم فی هذا الباب، وهو الذی یسمونه بکتاب (ایساغوجی) أی کتاب الکلیات الخمسة، حسب وضع مؤسس المنطق الحکیم (أرسطو). وکان علینا أن نتعرض لهذا الاصطلاح فی أول بحث الکلیات الخمسة، لولا أنا أردنا إیضاح المعنى المقصود منه بتقدیم شرح الکلیات الثلاثة المتقدمة، فنقول:
1- (الذاتی) هو المحمول الذی تتقوم ذات الموضوع به غیر خارج عنها. ونعنی (بما تتقوم ذات الموضوع به) أن ماهیة الموضوع لا تتحقق إلا به فهو قوامها، سواء کان هو نفس الماهیة کالإنسان المحمول على زید وعمرو، أو کان جزءاً منها کالحیوان المحمول على الإنسان أو الناطق المحمول علیه، فإن نفس الماهیة أو جزأها یسمى (ذاتیاً).
وعلیه، فالذاتی یعم النوع والجنس والفصل، لأن النوع نفس الماهیة الداخلة فی ذات الأفراد، والجنس والفصل جزآن داخلان فی ذاتها.
2- (العرضی) هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع، لاحقاً له بعد تقومه بجمیع ذاتیاته، کالضاحک اللاحق للإنسان، والماشی اللاحق للحیوان، والمتحیز اللاحق للجسم.
وعندما یتضح هذا الاصطلاح ندخل الآن فی بحث باقی الکلیات الخمسة، وقد بقی منها أقسام العرضی، فإن العرضی ینقسم إلى:
الخاصة والعرض العام:
لأن العرضی: إما أن یختص بموضوعه الذی حمل علیه أی لا یعرض لغیره، فهو (الخاصة) سواء کانت مساویة لموضوعها کالضاحک بالنسبة إلى الإنسان، أو کانت مختصة ببعض أفراده کالشاعر والخطیب والمجتهد العارضة على بعض أفراد الإنسان. وسواء کانت خاصة للنوع الحقیقی کالأمثلة السابقة، أو للجنس المتوسط کالمتحیز خاصة الجسم، والماشی خاصة الحیوان، أو لجنس الأجناس، کالموجود لا فی موضوع خاصة الجوهر.
وإما أن یعرض لغیر موضوعه أیضاً أی لا یختص به فهو (العرض العام) کالماشی بالقیاس إلى الإنسان، والطائر بالقیاس إلى الغراب، والمتحیز بالقیاس إلى الحیوان، أو بالقیاس إلى الجسم النامی.
وعلیه، یمکن تعریف الخاصة والعرض العام بما یأتی: (الخاصة) الکلی الخارج المحمول الخاص بموضوعه. (العرض العام) الکلی الخارج المحمول على موضوعه وغیره.
تنبیهات و توضیحات
1- قد یکون الشیء الواحد خاصة بالقیاس إلى موضوع وعرضاً عاماً بالقیاس إلى آخر، کالماشی، فإنه خاصة للحیوان وعرض عام للإنسان. ومثله، الموجود لا فی موضوع، والمتحیز، ونحوها، مما یعرض الأجناس.
2- وقد یکون الشیء الواحد عرضیاً بالقیاس إلى موضوع، وذاتیاً بالقیاس إلى آخر، کالملون، فإنه خاصة الجسم مع أنه جنس للأبیض والأسود ونحوهما. ومثله مفرق البصر، فإنه عرضی بالقیاس إلى الجسم مع أنه فصل للأبیض، لأن الأبیض (ملون مفرق البصر).
3- کل من الخاصة والفصل قد یکون مفرداً وقد یکون مرکباً. مثال المفرد منهما الضاحک والناطق. ومثال المرکب من الخاصة قولنا للإنسان: «منتصب القامة بادی البشرة». ومثال المرکب من الفصل قولنا للحیوان: «حساس متحرک بالإرادة».
الصنف
4- تقدم أن الفصل یقوم النوع ویمیزه عن أنواع جنسه، أی یقسم ذلک الجنس، أو فقل (ینوع) الجنس. أما الخاصة فإنها لا تقوّم الکلی الذی تختص به قطعاً، إلا أنها تمیزه عن غیره، أی أنها تقسم ما فوق ذلک الکلی. فهی کالفصل من هذه الناحیة فی کونها تقسم الجنس، وتزید علیه بأنها تقسم العرض العام أیضاً، کالموجود لا فی موضوع الذی یقسم (الموجود) إلى جوهر وغیر جوهر.
وتزید علیه أیضاً بأنها تقسم کذلک النوع، وذلک عندما تختص ببعض أفراد النوع کما تقدم، کالشاعر المقسم للإنسان. وهذا التقسیم للنوع یسمى فی اصطلاح المنطقیین (تصنیفاً)، وکل قسم من النوع یسمى (صنفاً).
فالصنف: کل کلی أخص من النوع ویشترک مع باقی أصناف النوع فی تمام حقیقتها، ویمتاز عنها بأمر عارض خارج عن الحقیقة.
والتصنیف کالتنویع، إلا أن التنویع للجنس باعتبار الفصول الداخلة فی حقیقة الأقسام. والتصنیف للنوع باعتبار الخواص الخارجة عن حقیقة الأقسام کتصنیف الإنسان إلى شرقی وغربی، وإلى عالم وجاهل، وإلى ذکر وأنثى... وکتصنیف الفرس إلى أصیل وهجین، وتصنیف النخل إلى زهدی وبربن وعمرانی... إلى ما شاء الله من التقسیمات للأنواع باعتبار أمور عارضة خارجة عن حقیقتها.
الحمل و انواعه
5- وصفنا کلاً من الکلیات الخمسة (بالمحمول). وأشرنا إلى أن الکلی المحمول ینقسم إلى الذاتی والعرضی. وهذا أمر یحتاج إلى التوضیح والبیان.
لأن سائلاً قد یسأل فیقول: أن النوع قد یحمل على الجنس، کما یقال مثلاً: الحیوان إنسان وفرس وجمل... إلى آخره، مع أن الإنسان بالقیاس إلى الحیوان لیس ذاتیاً له، لأنه لیس تمام الحقیقة ولا جزأها، ولا عرضیاً خارجاً عنه. أفهناک واسطة بین الذاتی والعرضی أم ماذا؟
وقد یسأل ـ ثانیاً ـ فیقول: أن الحد التام یحمل على النوع والجنس، کما یقال: الإنسان حیوان ناطق. والحیوان جسم تام حساس متحرک بالإرادة. وعلیه فالحد التام کلی محمول، وهو تمام حقیقة موضوعه، مع أنه لیس نوعاً له ولا جنساً ولا فصلاً، فینبغی أن یجعل للذاتی قسماً رابعاً. بل لا ینبغی تسمیته بالذاتی لأنه هو نفس الذات والشیء لا ینسب إلى نفسه، ولا بالعرضی لأنه لیس بخارج عن موضوعه، فیجب أن یکون واسطة بین الذاتی والعرضی.
وقد یسأل ـ ثالثاً ـ فیقول: أن المنطقیین یقولون أن الضحک خاصة الإنسان والمشی عرض عام له مثلاً، مع أن الضحک والمشی لا یحملان على الإنسان، فلا یقال الإنسان ضحک، وقد ذکرتم أن الکلیات کلها محمولات على موضوعاتها، فما السر فی ذلک؟ ولکن هذا السائل إذا اتضح له المقصود من (الحمل) ینقطع لدیه الکلام، فإن الحمل له ثلاثة تقسیمات.
والمراد منه هنا بعض أقسامه فی کل من التقسیمات فنقول:
.
1- الحمل: طبعی ووضعی:
اعلم أن کل محمول فهو کلی حقیقی، لأن الجزئی الحقیقی بما هو جزئی لا یحمل على غیره. وکل کلی أعم بحسب المفهوم فهو محمول بالطبع على ما هو أخص منه مفهوماً، کحمل الحیوان على الإنسان، والإنسان على محمد، بل وحمل الناطق على الإنسان. ویسمى مثل هذا (حملاً طبعیاً) أی اقتضاه الطبع ولا یأباه.
وأما العکس، وهو حمل الأخص مفهوماً على الأعم، فلیس هو حملاً طبعیاً، بل بالوضع والجعل، لأنه یأباه الطبع ولا یقبله فلذلک یسمى (حملاً وضعیاً) أو جعلیاً. ومرادهم بالأعم بحسب المفهوم غیر الأعم بحسب المصداق الذی تقدم الکلام علیه فی النسب: فإن الأعم قد یراد منه الأعم باعتبار وجوده فی أفراد الأخص وغیر أفراده کالحیوان بالقیاس إلى الإنسان وهو المعدود فی النسب. وقد یراد منه الأعم باعتبار المفهوم فقط وإن کان مساویاً بحسب الوجود، کالناطق بالقیاس إلى الإنسان، فإن مفهومه أنه شیء ما له النطق من غیر التفات إلى کون ذلک الشیء إنساناً أو لم یکن، وإنما یستفاد کون الناطق إنساناً دائماً من خارج المفهوم. فالناطق بحسب المفهوم أعم من الإنسان وکذلک الضاحک، وإن کانا بحسب الوجود مساویین له... وهکذا جمیع المشتقات لا تدل على خصوصیة ما تقال علیه کالصاهل بالقیاس إلى الفرس والباغم للغزال والصادح للبلبل والماشی للحیوان.
وإذا اتضح ذلک یظهر الجواب عن السؤال الأول، لأن المقصود من المحمول فی الکلیات الخمسة المحمول بالطبع لا مطلقاً.
2- الحمل: ذاتی أولی، وشایع صناعی:
واعلم أن معنى الحمل هو الاتحاد بین شیئین، لأن معناه أن هذا ذاک. وهذا المعنى کما یتطلب الاتحاد بین الشیئین یستدعی المغایرة بینهما، لیکونا حسب الفرض شیئین. ولولاها لم یکن إلا شیء واحد لا شیئان.
وعلیه، لابدّ فی الحمل من الاتحاد من جهة والتغایر من جهة أخرى، کما یصح الحمل. ولذا لا یصح الحمل بین المتباینین إذ لا اتحاد بینهما. ولا یصح حمل الشیء على نفسه، إذ الشیء لا یغایر نفسه.
ثم إن هذا الاتحاد إما أن یکون فی المفهوم، فالمغایرة لابدّ أن تکون اعتباریة. ویقصد بالحمل حینئذ أن مفهوم الموضوع هو بعینه نفس مفهوم المحمول وماهیته، بعد أن یلحظا متغایرین بجهة من الجهات. مثل قولنا:
(الإنسان حیوان ناطق) فإن مفهوم الإنسان ومفهوم حیوان ناطق واحد إلا أن التغایر بینهما بالإجمال والتفصیل، وهذا النوع من الحمل یسمى (حملاً ذاتیاً أولیاً).
وإما أن یکون الاتحاد فی الوجود والمصداق، والمغایرة بحسب المفهوم. ویرجع الحمل حینئذٍ إلى کون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصادیقه. مثل قولنا: (الإنسان حیوان) فإن مفهوم إنسان غیر مفهوم حیوان، ولکن کل ما صدق علیه الإنسان صدق علیه الحیوان. وهذا النوع من الحمل یسمى (الحمل الشایع الصناعی) أو (الحمل المتعارف) لأنه هو الشایع فی الاستعمال المتعارف فی صناعة العلوم.
وإذا اتضح هذا البیان یظهر الجواب عن السؤال الثانی أیضاً، لأن المقصود من المحمول فی باب الکلیات هو المحمول بالحمل الشایع الصناعی. وحمل الحد التام من الحمل الذاتی الأولى.
3- الحمل: مواطاة واشتقاق:
إذا قلنا: الإنسان ضاحک، فمثل هذا الحمل یسمى (حمل مواطاة) أو (حمل هوهو) ومعناه أن ذات الموضوع نفس المحمول. وإذا شئت فقل معناه. هذا ذاک. والمواطاة معناها الاتفاق. وجمیع الکلیات الخمسة یحمل بعضها على بعض وعلى أفرادها بهذا الحمل.
وعندهم نوع آخر من الحمل یسمى (حمل اشتقاق) أو حمل (ذو هو) کحمل الضحک على الإنسان، فإنه لا یصح أن تقول الإنسان ضحک، بل ضاحک أو ذو ضحک.
وسمی حمل اشتقاق وذو هو، لأن هذا المحمول بدون أن یشتق منه اسم کالضاحک أو یضاف إلیه (ذو) لا یصح حمله على موضوعه، فیقال للمشتق کالضاحک محمولاً بالمواطاة، وللمشتق منه کالضحک محمولاً بالاشتقاق.
والمقصود بیانه أن المحمول بالاشتقاق کالضحک والمشی والحس لا یدخل فی أقسام الکلیات الخمسة، فلا یصح أن یقال: الضحک خاصة للإنسان، ولا اللون خاصة للجسم، ولا الحس فصل للحیوان، بل الضاحک والملون هو الخاصة، والحساس هو الفصل... وهکذا. وإذا وقع فی کلمات القوم شیء من هذا القبیل فمن التساهل فی التعبیر الذی قد یشوش أفکار المبتدئین، إذ ترى بعضهم یعبر بالضحک ویرید منه الضاحک. وبهذا یظهر الجواب عن السؤال الثالث. نعم (اللون) بالقیاس إلى البیاض کلی وهو جنس له، لأنک تحمله علیه حمل مواطاة، فتقول: البیاض لون. أما اللون والبیاض بالقیاس إلى الجسم فلیسا من الکلیات المحمولة علیه.
العروض معناه الحمل
6- ثم لا یشتبه علیک الأمر، فتقول: أنکم قلتکم الکلی الخارج إن عرض على موضوعه فقط فهو الخاصة وإلا فالعرض العام. والضحک لا شک یعرض على الإنسان ومختص به. فإذن یجب أن یکون خاصة.
فإنا نرفع هذا الاشتباه ببیان العروض المقصود به فی الباب، فإن المراد منه هو الحمل حملاً عرضیاً لا ذاتیاً. وعلیه فالضحک لا یعرض على الإنسان بهذا المعنى. وإذا قیل یعرض على الإنسان فبمعنى آخر للعروض وهو الوجود فیه.
وعندهم تعبیر آخر بسبب الاشتباه، وهو قولهم الکلی الخارج عرض خاص وعرض عام، فیطلقون العرض على الکلی الخارج، ثم یقولون لمثل الضحک أنه عرض. والمقصود بالعرض فی التعبیر الأول هو العرضی مقابل الذاتی، والمقصود بالعرض فی الثانی هو الموجود فی الموضوع مقابل الجوهر الموجود لا فی موضوع.
ومثل اللون یسمى عرضاً بالمعنى الثانی لأنه موجود فی موضوع، ولکن لا یصح أن یسمى عرضاً بالمعنى الأول أبداً، لأنه بالقیاس إلى الجسم لا یحمل علیه حمل مواطاة وبالقیاس إلى ما تحته من الأنواع کالسواد والبیاض هو جنس لها کما تقدم، فهو حینئذ ذاتی لا عرضی.
تقسیمات العرضی
العرضی: لازم ومفارق.
1- (اللازم) ما یمتنع انفکاکه عقلاً عن موضوعه، کوصف (الفرد) للثلاثة و(الزوج) للأربعة، و(الحارة) للنار...
2- (المفارق) ما (لا) یمتنع انفکاکه عقلاً عن موضوعه، کأوصاف الإنسان المشتقة من أفعاله وأحواله، مثل قائم وقاعد ونائم وصحیح وسقیم، وما إلى ذلک، وإن کان لا ینفک أبداً: فإنک ترى أن وصف العین (بالزرقاء) لا ینفک عن وجود العین، ولکنه مع ذلک یعد عرضیاً مفارقاً، لأنه لو أمکنت حیلة لإزالة الزرقة لما امتنع ذلک وتبقى العین عیناً. وهذا لا یشبه اللازم، فلو قدرت حیلة لسلخ وصف الفرد عن الثلاثة لما أمکن أن تبقى الثلاثة ثلاثة، ولو قدرت سلخ وصف الحرارة عن النار لبطل وجود النار. وهذا معنى امتناع الانفکاک عقلاً.
اللازم: بیّن وغیر بیّن.
البیّن: بیّن بالمعنى الأخص، وبین بالمعنى الأعم.
1- (البین بالمعنى الأخص) ما یلزم من تصور ملزومه تصوره، بلا حاجة إلى توسط شیء آخر.
2- (البین بالمعنى الأعم) ما یلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبة بینهما الجزم بالملازمة. مثل: الاثنان نصف الأربعة أو ربع الثمانیة، فإنک إذا تصورت الاثنین قد تغفل عن أنها نصف الأربعة أو ربع الثمانیة، ولکن إذا تصورت أیضاً الثمانیة مثلاً، وتصورت النسبة بینهما تجزم أنها ربعها. وکذا إذا تصورت الأربعة والنسبة بینهما تجزم أنها نصفها... وهکذا فی نسبة الأعداد بعضها إلى بعض. ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمة لوجوب ذی المقدمة، فإنک إذا تصورت وجوب الصلاة، وتصورت الوضوء، وتصورت النسبة بینه وبین الصلاة وهی توقف الصلاة الواجبة علیه، حکمت بالملازمة بین وجوب الصلاة ووجوبه.
وإنما کان هذا القسم من البین أعم، لأنه لا یفرق فیه بین أن یکون تصور الملزوم کافیاً فی تصور اللازم وانتقال الذهن إلیه وبین ألا یکون کافیاً، بل لابدّ من تصور اللازم وتصور النسبة للحکم بالملازمة. وإنما یکون تصور الملزوم کافیاً فی تصور اللازم عندما یألف الذهن الملازمة بین الشیئین على وجه یتداعى عنده المتلازمان فإذا وُجد أحدهما فی الذهن وجد الآخر تبعاً له، فتکون الملازمة حینئذٍ ذهنیة.
3- (غیر البیّن) وهو ما یقابل البین مطلقاً، بأن یکون التصدیق والجزم بالملازمة لا یکفی فیه تصور الطرفین والنسبة بینهما. بل یحتاج إثبات الملازمة إلى إقامة الدلیل علیه. مثل الحکم بأن المثلث زوایاه تساوی قائمتین، فإن الجزم بهذه الملازمة یتوقف على البرهان الهندسی، ولا یکفی تصور زوایا المثلث وتصور القائمتین وتصور النسبة للحکم بالتساوی.
والخلاصة:
معنى البین مطلقاً ما کان لزومه بدیهیاً، وغیر البین ما کان لزومه نظریاً.
المفارق: دائم وسریع الزوال وبطیئه.
(الدائم) کوصف الشمس بالمتحرکة، ووصف العین بالزرقاء.
(سریع الزوال) کحمرة الخجل وصفرة الخوف.
(بطیء الزوال) کالشباب للإنسان.
***
الکلی المنطقی والطبیعی والعقلی
إذا قیل: (الإنسان کلی) مثلاً، فهنا ثلاثة أشیاء: ذات الإنسان بما هو إنسان، ومفهوم الکلی بما هو کلی مع عدم الالتفات إلى کونه إنساناً أو غیر إنسان، والإنسان بوصف کونه کلیاً. أو فقل الأشیاء الثلاثة هی: ذات الموصوف مجرداً، ومفهوم الوصف مجرداً، والمجموع من الموصوف والوصف.
1- فإن لاحظ العقل (والعقل قادر على هذه التصرفات) نفس ذات الموصوف بالکلی مع قطع النظر عن الوصف، بأن یعتبر الإنسان، مثلاً، بما هو إنسان من غیر التفات إلى أنه کلی أو غیر کلی، وذلک عندما یحکم علیه بأنه حیوان ناطق ـ فإنه أی ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظة یسمى (الکلی الطبیعی). ویقصد به طبیعة الشیء بما هی
. والکلی الطبیعی موجود فی الخارج بوجود أفراده.
2- وإن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالکلی وحده، وهو أن یلاحظ مفهوم (ما لا یمتنع فرض صدقه على کثیرین) مجرداً عن کل مادة مثل إنسان وحیوان وحجر وغیرها ـ فإنه أی مفهوم الکلی بما هو عند هذه الملاحظة، یسمى (الکلی المنطقی).
والکلی المنطقی لا وجود له إلا فی العقل، لأنه مما ینتزعه ویفرضه العقل، فهو من المعانی الذهنیة الخالصة التی لا موطن لها خارج الذهن.
3- وإن لاحظ العقل المجموع من الوصف والموصوف، بأن لا یلاحظ ذات الموصوف وحده مجرداً، بل بما هو موصوف بوصف الکلیة، کما یلاحظ الإنسان بما هو کلی لا یمتنع صدقه على الکثیر ـ فإنه أی الموصوف بما هو موصوف بالکلی یسمى (الکلی العقلی) لأنه لا وجود له إلا فی العقل، لاتصافه بوصف عقلی، فإن کل موجود فی الخارج لابد أن یکون جزئیاً حقیقیاً.
ونشبه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضیحها بما إذا قیل: (السطح فوق) فإذا لاحظت (ذات السطح) بما یشتمل علیه من آجر وخشب ونحوهما وقصرت النظر على ذلک غیر ملتفت إلى أنه فوق أو تحت، فهو شبیه بالکلی الطبیعی. وإذا لاحظت مفهوم (الفوق) وحده مجرداً عن شیء هو فوق، فهو شبیه بالکلی المنطقی. وإذا لاحظت ذات السطح بوصف أنه فوق. فهو شبیه بالکلی العقلی.
واعلم أن جمیع الکلیات الخمسة وأقسامها، بل الجزئی أیضاً، تصح فیها هذه الاعتبارات الثلاثة، فیقال على قیاس ما تقدم: نوع طبیعی ومنطقی وعقلی، وجنس طبیعی ومنطقی وعقلی... إلى آخرها.
فالنوع الطبیعی مثل إنسان بما هو إنسان، والنوع المنطقی هو مفهوم «تمام الحقیقة المشترکة بین الجزئیات المتکثرة بالعدد فی جواب ما هو»، والنوع العقلی هو مفهوم الإنسان بما هو تمام الحقیقة المشترکة بین الجزئیات المتکثرة بالعدد... وهکذا یقال فی باقی الکلیات وفی الجزئی أیضاً.
*الباب الثالث: المعرف و تلحق به القسمه*
المقدمة: فی مطلب ما وأی وهل ولم.
إذا اعترضتک لفظة من أیة لغة کانت، فهنا خمس مراحل متوالیة، لابد لک من اجتیازها لتحصیل المعرفة، فی بعضها یطلب العلم التصوری، وفی بعضها الآخر العلم التصدیقی.
(المرحلة الأولى): تطلب فیها تصور معنى اللفظ تصوراً إجمالیاً، فتسأل عنه سؤالاً لغویاً صرفاً، إذا لم تکن تدری لأی معنى من المعانی قد وضع. والجواب یقع بلفظ آخر یدل على ذلک المعنى، کما إذا سألت عن معنى لفظ (غضنفر)، فیجاب: أسد. وعن معنى (سُمیدع)، فیجاب: سید... وهکذا. ویسمى مثل هذا الجواب (التعریف اللفظی). وقوامیس اللغات هی المتعهدة بالتعاریف اللفظیة.
وإذا تصورت معنى اللفظ إجمالاً، فزعت نفسک إلى:
(المرحلة الثانیة): إذ تطلب تصور ماهیة المعنى، أی تطلب تفصیل ما دل علیه الاسم إجمالا. لتمییزه عن غیره فی الذهن تمییزاً تاماً، فتسأل عنه بکلمة (ما) فتقول: (..... ما هو؟).
وهذه (ما) تسمى (الشارحة)، لأنها یسأل بها عن شرح معنى اللفظ. والجواب عنه یسمى (شرح الاسم) وبتعبیر آخر (التعریف الاسمی). والأصل فی الجواب أن یقع بجنس المعنى وفصله القریبین معاً، ویسمى (الحد التام الاسمی). ویصح أن یجاب بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها، أو بأحدهما منضماً إلى الجنس البعید، أو بالخاصة منضمة إلى الجنس القریب. وتسمى هذه الأجوبة تارة بالحد الناقص وأخرى بالرسم الناقص أو التام، ولکنها توصف جمیعاً بالاسمی. وسیأتیک تفصیل هذه الاصطلاحات. ولو فرض أن المسؤول أجاب خطأ بالجنس القریب وحده، کما لو قال (شجرة) فی جواب (ما النخلة) ـ فإن السائل لا یقنع بهذا الجواب، وتتوجه نفسه إلى السؤال عن ممیزاتها عن غیرها، فیقول: (أیة شجرة هی فی ذاتها) أو (أیة شجرة هی فی خاصتها)، فیقع الجواب عن الأول بالفصل وحده فیقول: (مثمرة التمر)، وعن الثانی بالخاصة فیقول: (ذات السعف) مثلاً.
وهذا هو موقع السؤال بکلمة (أی). وجوابها الفصل أو الخاصة. ـ وإذا حصل لک العلم بشرح المعنى تفزع نفسک إلى:
(المرحلة الثالثة): وهی طلب التصدیق: بوجود الشیء، فتسأل عنه بـ (هل) وتسمى (هل البسیطة)، فتقول: هل وجد کذا، أو هل هو موجود
(ما) الحقیقیة:
تنبیه: إن هاتین المرحلتین الثانیة والثالثة تتعاقبان فی التقدم والتأخر، فقد تتقدم الثانیة، على حسب ما رتبناهما وهو الترتیب الذی یقتضیه الطبع، وقد تتقدم الثالثة، وذلک عندما یکون السائل من أول الأمر عالماً بوجود الشیء المسؤول عنه، أو أنه على خلاف الطبع قدم السؤال عن وجوده فأجیب.
وحینئذٍ إذا کان عالماً بوجود الشیء قبل العلم بتفصیل ما أجمله اللفظ الدال علیه، ثم سأل عنه بـ (ما)، فإن ما هذه تسمى (الحقیقیة). والجواب عنها نفس الجواب عن (ما الشارحة)، بلا فرق بینهما إلا من جهة تقدم الشارحة على العلم بوجوده وتأخر الحقیقیة عنه.
وإنما سمیت حقیقیة، لأن السؤال بها عن الحقیقة الثابتة ـ والحقیقة باصطلاح المناطقة هی الماهیة الموجودة ـ والجواب عنها یسمى (تعریفاً حقیقیاً) وهو نفسه الذی کان یسمى (تعریفاً اسمیاً) قبل العلم بالوجود ولذا قالوا:
«الحدود قبل الهلیات البسیطة حدود اسمیة وهی بأعیانها بعد الهلیات تنقلب حدوداً حقیقیة».
ـ وإذا حصلت لک هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى:
(المرحلة الرابعة): وهی طلب التصدیق بثبوت صفة أو حال للشیء، ویسأل عنه بـ (هل) أیضاً، ولکن تسمى هذه (هل المرکبة)، لأنه یسأل بها عن ثبوت شیء لشیء بعد فرض وجوده، والبسیطة یسأل بها عن ثبوت الشیء فقط، فیقال للسؤال بالبسیطة مثلاً: هل الله موجود. وللسؤال بالمرکبة بعد ذلک: هل الله الموجود مرید. فإذا أجابک المسؤول عن هل البسیطة أو المرکبة تنزع نفسک إلى:
(المرحلة الخامسة): وهی طلب العلة: إما علة الحکم فقط أی البرهان على ما حکم به المسؤول فی الجواب عن هل أو علة الحکم وعلة الوجود معاً، لتعرف السبب فی حصول ذلک الشیء واقعاً. ویسأل لأجل کل من الغرضین بکلمة (لِمَ) الاستفهامیة، فتقول لطلب علة الحکم مثلاً: (لِمَ کان الله مریداً). وتقول مثلاً لطلب علة الحکم وعلة الوجود معاً: (لِمَ کان المغناطیس جاذباً للحدید؟)، کما لو کنت قد سألت هل المغناطیس جاذب للحدید؟ فأجاب المسؤول بنعم، فإن حقک أن تسأل ثانیاً عن العلة فتقول (لِمَ).
تلخیص وتعقیب:
ظهر مما تقدم أن:
(ما) لطلب تصور ماهیة الشیء. تنقسم إلى الشارحة والحقیقیة. ویشتق منها مصدر صناعی، فیقال: (مائیة). ومعناه الجواب عن ما. کما أن (ماهیة) مصدر صناعی من (ما هو).
و(أی) لطلب تمییز الشیء عما یشارکه فی الجنس تمییزاً ذاتیاً أو عرضیاً، بعد العلم بجنسه.
و(هل) تنقسم إلى «بسیطة» ویطلب بها التصدیق بوجود الشیء أو عدمه، و«مرکبة» ویطلب بها التصدیق بثبوت شیء لشیء أو عدمه، ویشتق منها مصدر صناعی،
فیقال: (الهلیة) البسیطة أو المرکبة.
و(لِمَ) یطلب بها تارة علة التصدیق فقط، وأخرى علة التصدیق والوجود معاً. ویشتق منها مصدر صناعی، فیقال (لَمیَّة) بتشدید المیم والیاء. مثل (کمیة) من (کم) الاستفهامیة. فمعنى لمیَّة الشیء: علیّته.
فروع المطالب:
ما تقدم هی أصول المطالب التی یسأل عنها بتلک الأدوات، وهی المطالب الکلیة التی یبحث عنها فی جمیع العلوم. وهناک مطالب أخرى یسأل عنها بکیف وأین ومتى وکم ومن. وهی مطالب جزئیة أی أنها لیست من أمهات المسائل بالقیاس إلى المطالب الأولى لعدم عموم فائدتها، فإن ما لا کیفیة له مثلاً لا یسأل عنه بکیف، وما لا مکان له أو زمان لا یسأل عنه بأین ومتى. على أنه یجوز أن یستغنى عنها غالباً بمطلب هل المرکبة، فبدلاً عن أن تقول مثلاً: (کیف لون ورق الکتاب؟ وأین هو؟ ومتى طبع؟..) تقول: (هل ورق الکتاب أبیض؟ وهل هو فی المکتبة؟ وهل طبع هذا العام؟..) وهکذا. ولذا وصفوا هذه المطالب بالفروع، وتلک بالأصول.
***
التعریف - التمهید
کثیراً ما تقع المنازعات فی المسائل العلمیة وغیرها حتى السیاسیة لأجل الإجمال فی مفاهیم الألفاظ التی یستعملونها، فیضطرب حبل التفاهم، لعدم اتفاق المتنازعین على حدود معنى اللفظ، فیذهب کل فرد منهم إلى ما یختلج فی خاطره من المعنى. وقد لا تکون لأحدهم صورة واضحة للمعنى مرسومة بالضبط فی لوحة ذهنه، فیقنع ـ لتساهله أو لقصور مدارکه ـ بالصورة المطموسة المضطربة، ویبنی علیها منطقه المزیف.
وقد یتبع الجدلیون والساسة ـ عن عمد وحیلة ـ ألفاظاً خلابة غیر محدودة المعنى بحدود واضحة، یستغلون جمالها وإبهامها للتأثیر على الجمهور، ولیترکوا کل واحد یفکر فیها بما شاءت له خواطره الخاطئة أو الصحیحة، فیبقى معنى الکلمة بین أفکار الناس کالبحر المضطرب. ولهذا تأثیر سحری عجیب فی الأفکار.
ومن هذه الألفاظ کلمة (الحریة) التی أخذت مفعولها من الثورة الفرنسیة، وأحداث الانقلابات الجبارة فی الدولة العثمانیة والفارسیة، والتأثیر کله لإجمالها وجمالها السطحی الفاتن، وإلا فلا یستطیع العلم أن یحدها بحد معقول یتفق علیه.
ومثلها کلمة (الوطن) الخلابة التی استغلها ساسة الغرب لتمزیق بعض الدول الکبرى کالدولة العثمانیة. وربما یتعذر على الباحث أن یعرف اثنین کانا یتفقان على معنى واحد واضح کل الاتفاق یوم ظهور هذه الکلمة فی قاموس النهضة الحدیثة: فما هی ممیزات الوطن؟ أهی اللغة أم لهجتها أم اللباس أم مساحة الأرض أم اسم القطر والبلد؟ بل کل هذا غیر مفهوم حتى الآن على وجه تتفق علیه جمیع الناس والأمم. ومع ذلک نجد کل واحد منا فی البلاد العربیة یدافع عن وطنه، فلماذا لا تکون البلاد العربیة أو البلاد الإسلامیة کلها وطناً واحداً؟
فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق ـ لئلا یرتطم هو والمشتغل معه فی المشاکل ـ أن یفرغ مفردات مقاصده فی قالب سهل من التحدید والشرح، فیحفظ ما یدور فی خلده من المعنى فی آنیة من الألفاظ وافیة به لا تفیض علیها جوانبها، لینقله إلى ذهن السامع أو القارئ کما کان مخزوناً فی ذهنه بالضبط. وعلى هذا الأساس المتین یبنى التفکیر السلیم.
ولأجل أن یتغلب الإنسان على قلمه ولسانه وتفکیره لابدّ له من معرفة أقسام التعریف وشروطه وأصوله وقواعده، لیستطیع أن یحتفظ فی ذهنه بالصور الواضحة للأشیاء أولاً، وأن ینقلها إلى أفکار غیره صحیحة ثانیاً... فهذه حاجتنا لمباحث التعریف.
***
اقسام التعریف
التعریف: حد ورسم.
الحد والرسم: تام وناقص.
سبق أن ذکرنا (التعریف اللفظی). ولا یهمنا البحث عنه فی هذا العلم، لأنه لا ینفع إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعناه، فلا یستحق اسم التعریف إلا من باب المجاز والتوسع. وإنما غرض المنطقی من (التعریف) هو المعلوم التصوری الموصل إلى مجهول تصوری الواقع جواباً عن (ما) الشارحة أو الحقیقیة. ویقسم إلى حد ورسم، وکل منهما إلى تام وناقص.
1- الحد التام:
وهو التعریف بجمیع ذاتیات المعرَّف (بالفتح)، ویقع بالجنس والفصل القریبین
لاشتمالهما على جمیع ذاتیات المعرف، فإذا قیل: ما الإنسان؟ فیجوز أن تجیب - أولاً - بأنه: (حیوان ناطق). وهذا حد تام فیه تفصیل ما أجمله اسم الإنسان، ویشتمل على جمیع ذاتیاته، لأن مفهوم الحیوان ینطوی فیه الجوهر والجسم النامی والحساس المتحرک بالإرادة. وکل هذه أجزاء وذاتیات للإنسان.
ویجوز أن تجیب - ثانیاً - بأنه: (جسم نام حساس متحرک بالإرادة، ناطق). وهذا حد تام أیضاً للإنسان عین الأول فی المفهوم إلا أنه أکثر تفصیلاً، لأنک وضعت مکان کلمة (حیوان) حده التام. وهذا تطویل وفضول لا حاجة إلیه، إلا إذا کانت ماهیة الحیوان مجهولة للسائل، فیجب.
وهکذا إذا کان الجوهر مجهولاً تضع مکانه حده التام ـ إن وجد ـ حتى ینتهی الأمر إلى المفاهیم البدیهیة الغنیة عن التعریف کمفهوم الموجود والشیء.... وقد ظهر من هذا البیان:
أولاً- أن الجنس والفصل القریبین تنطوی فیهما جمیع ذاتیات المعرف لا یشذ منها جزء أبداً، ولذا سمی الحد بهما (تاماً).
وثانیاً- أن لا فرق فی المفهوم بین الحدود التامة المطولة والمختصرة إلا أن المطولة أکثر تفصیلاً. فیکون التعریف بها واجباً تارة وفضولاً أخرى.
وثالثاً- أن الحد التام یساوی المحدود فی المفهوم، کالمترادفین، فیقوم مقام الاسم بأن یفید فائدته، ویدل على ما یدل علیه الاسم إجمالاً.
ورابعاً- أن الحد التام یدل على المحدود بالمطابقة.
2- الحد الناقص:
وهو التعریف ببعض ذاتیات المعرَّف (بالفتح)، ولابد أن یشتمل على الفصل القریب على الأقل. ولذا سمی (ناقصاً). وهو یقع تارة بالجنس البعید والفصل القریب، وأخرى بالفصل وحده.
مثال الأول – تقول لتحدید الإنسان: (جسم نام... ناطق)، فقد نقصت من الحد التام المذکور فی الجواب الثانی المتقدم صفة (حساس متحرک بالإرادة) وهی فصل الحیوان، وقد وقع النقص مکان النقط بین جسم نام، وبین ناطق، فلم یکمل فیه مفهوم الإنسان.
ومثال الثانی – تقول لتحدید الإنسان أیضاً: (... ناطق) فقد نقصت من الحد التام الجنس القریب کله. فهو أکثر نقصاناً من الأول کما ترى... وقد ظهر من هذا البیان: أولاً- إن الحد الناقص لا یساوی المحدود فی المفهوم، لأنه یشتمل على بعض أجزاء مفهومه. ولکنه یساویه فی المصداق.
وثانیاً- إن الحد الناقص لا یعطی للنفس صورة ذهنیة کاملة للمحدود مطابقة له، کما کان الحد التام، فلا یکون تصوره تصوراً للمحدود بحقیقته، بل أکثر ما یفید تمییزه عن جمیع ما عداه تمییزاً ذاتیاً فحسب.
وثالثاً- إنه لا یدل على المحدود بالمطابقة، بل بالالتزام، لأنه من باب دلالة الجزء المختص على الکل.
3- الرسم التام:
وهو التعریف بالجنس والخاصة، کتعریف الإنسان بأنه (حیوان ضاحک) فاشتمل على الذاتی والعرضی. ولذا سمی (تاماً).
4- الرسم الناقص:
وهو التعریف بالخاصة وحدها کتعریف الإنسان بأنه (ضاحک) فاشتمل على العرضی فقط، فکان (ناقصاً).
وقیل: إن التعریف بالجنس البعید والخاصة معدود من الرسم الناقص فیختص التام بالمؤلف من الجنس القریب والخاصة فقط.
ولا یخفى أن الرسم مطلقاً کالحد الناقص لا یفید إلا تمییز المعرَّف (بالفتح) عن جمیع ما عداه فحسب، إلا أنه یمیزه تمییزاً عرضیاً. ولا یساویه إلا فی المصداق لا فی المفهوم. ولا یدل علیه إلا بالالتزام. کل هذا ظاهر مما قدمناه.
إنارة:
إن الأصل فی التعریف هو الحد التام، لأن المقصود الأصلی من التعریف أمران:
(الأول) تصور المعرّف (بالفتح) بحقیقته لتتکون له فی النفس صورة تفصیلیة واضحة.
و(الثانی) تمییزه فی الذهن عن غیره تمییزاً تاماً.
ولا یؤدّى هذان الأمران إلا بالحد التام. وإذا تعذر الأمر الأول یکتفى بالثانی. ویتکفل به الحد الناقص والرسم بقسمیه. وإلاّ قدم تمییزه تمییزاً ذاتیاً ویؤدى ذلک بالحد الناقص فهو أولى من الرسم. والرسم التام أولى من الناقص.
إلا إن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشیاء وفصولها من الأمور المستحیلة أو المتعذرة. وکل ما یذکر من الفصول فإنما هی خواص لازمة تکشف عن الفصول الحقیقیة. فالتعاریف الموجودة بین أیدینا أکثرها أو کلها رسوم تشبه الحدود. فعلى من أراد التعریف أن یختار الخاصة اللازمة البینة بالمعنى الأخص، لأنها أدل على حقیقة المعرف وأشبه بالفصل. وهذا أنفع الرسوم فی تعریف الأشیاء. وبعده فی المنزلة التعریف بالخاصة اللازمة البینة بالمعنى الأعم. أما التعریف بالخاصة الخفیة غیر البینة فإنها لا تفید تعریف الشیء لکل أحد، فإذا عرفنا المثلث بأنه (شکل زوایاه تساوی قائمتین) فإنک لم تعرفه إلا للهندسی المستغنی عنه.
التعریف بالمثال والطریقة الاستقرائیة
کثیراً ما نجد العلماء ـ لا سیما علماء الأدب ـ یستعینون على تعریف الشیء بذکر أحد أفراده ومصادیقه مثالاً له. وهذا ما نسمیه (التعریف بالمثال) وهو أقرب إلى عقول المبتدئین فی فهم الأشیاء وتمییزها.
ومن نوع التعریف بالمثال (الطریقة الاستقرائیة) المعروفة فی هذا العصر التی یدعو لها علماء التربیة، لتفهیم الناشئة وترسیخ القواعد والمعانی الکلیة فی أفکارهم.
وهی: أن یکثر المؤلف أو المدرس ـ قبل بیان التعریف أو القاعدة ـ من ذکر الأمثلة والتمرینات، لیستنبط الطالب بنفسه المفهوم الکلی أو القاعدة. وبعدئذ تعطى له النتیجة بعبارة واضحة لیطابق بین ما یستنبط هو، وبین ما یعطى له بالأخیر من نتیجة.
والتعریف بالمثال لیس قسماً خامساً للتعریف، بل هو من التعریف بالخاصة، لأن المثال مما یختص بذلک المفهوم، فیرجع إلى (الرسم الناقص). وعلیه یجوز أن یکتفى به فی التعریف من دون ذکر التعریف المستنبط، إذا کان المثال وافیاً بخصوصیات الممثل له.
التعریف بالتشبیه
مما یلحق بالتعریف بالمثال ویدخل فی الرسم الناقص أیضاً (التعریف بالتشبیه). وهو أن یشبه الشیء المقصود تعریفه بشیء آخر لجهة شبه بینهما، على شرط أن یکون المشبه به معلوماً عند المخاطب بأن له جهة الشبه هذه.
ومثاله تشبیه الوجود بالنور، وجهة الشبه بینهما أن کلاً منهما ظاهر بنفسه مظهر لغیره. وهذا النوع من التعریف ینفع کثیراً فی المعقولات الصرفة، عندما یراد تقریبها إلى الطالب بتشبیهها بالمحسوسات، لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب ولتصورها آلف. وقد سبق منا تشبیه کل من النسب الأربع بأمر محسوس تقریباً لها، فمن ذلک تشبیه المتباینین بالخطین المتوازیین لأنهما لا یلتقیان أبداً. ومن هذا الباب المثال المتقدم وهو تشبیه الوجود بالنور، ومنه تشبیه التصور الآلی (کتصور اللفظ آلة لتصور المعنى) بالنظر إلى المرآة بقصد النظر إلى الصورة المنطبعة فیها.
شروط التعریف
الغرض من التعریف ـ على ما قدمنا ـ تفهیم مفهوم المعرَّف (بالفتح) وتمییزه عما عداه. ولا یحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة:
الأول ـ أن یکون المعرِّف (بالکسر) مساویاً للمعرَّف (بالفتح) فی الصدق، أی یجب أن یکون المعرِّف (بالکسر) مانعاً جامعاً. وإن شئت قلت (مطرداً منعکساً).
ومعنى مانع أو مطرد أنه لا یشمل إلا أفراد المعرَّف (بالفتح)، فیمنع من دخول أفراد غیره فیه.
ومعنى جامع أو منعکس أنه یشمل جمیع أفراد المعرَّف (بالفتح) لا یشذ منها فرد واحد.
فعلى هذا لا یجوز التعریف بالأمور الآتیة:
1- بالأعم: لأن الأعم لا یکون مانعاً، کتعریف الإنسان بأنه حیوان یمشی على رجلین، فإن جملة من الحیوانات تمشی على رجلین.
2- بالأخص: لأن الأخص لا یکون جامعاً، کتعریف الإنسان بأنه حیوان متعلم، فإنه لیس کل ما صدق علیه الإنسان هو متعلم.
3- بالمباین: لأن المتباینین لا یصح حمل أحدهما على الآخر، ولا یتصادقان أبداً.
الثانی ـ أن یکون المعرِّف (بالکسر) أجلى مفهوماً وأعرف عند المخاطب من المعرَّف (بالفتح). وإلا فلا یتم الغرض من شرح مفهومه، فلا یجوز ـ على هذا ـ التعریف بالأمرین الآتیین:
1- بالمساوی فی الظهور والخفاء، کتعریف الفرد بأنه عدد ینقص عن الزوج بواحد، فإن الزوج لیس أوضح من الفرد ولا أخفى، بل هما متساویان فی المعرفة. کتعریف أحد المتضایفین بالآخر، وأنت إنما تتعقلهما معاً، کتعریف الأب بأنه والد الابن. وکتعریف الفوق بأنه لیس بتحت...
2- بالأخفى معرفة، کتعریف النور بأنه قوة تشبه الوجود.
الثالث ـ ألا یکون المعرِّف (بالکسر) عین المعرَّف (بالفتح) فی المفهوم، کتعریف الحرکة بالانتقال والإنسان بالبشر تعریفاً حقیقیاً غیر لفظی، بل یجب تغایرهما إما بالإجمال والتفصیل کما فی الحد التام أو بالمفهوم کما فی التعریف بغیره.
ولو صح التعریف بعین المعرَّف لوجب أن یکون معلوماً قبل أن یکون معلوماً، وللزم أن یتوقف الشیء على نفسه. وهذا محال. ویسمون مثل هذا نتیجة الدور الذی سیأتی بیانه.
الرابع ـ أن یکون خالیاً من الدور. وصورة الدور فی التعریف: أن یکون المعرِّف (بالکسر) مجهولاً فی نفسه، ولا یعرف إلا بالمعرَّف (بالفتح)، فبینما أن المقصود من التعریف هو تفهیم المعرَّف (بالفتح) بواسطة المعرِّف (بالکسر)، وإذا بالمعرِّف (بالکسر) فی الوقت نفسه إنما یفهم بواسطة المعرَّف (بالفتح)، فینقلب المعرَّف (بالفتح) معرِّفاً (بالکسر).
وهذا محال، لأنه یؤول إلى أن یکون الشیء معلوماً قبل أن یکون معلوماً، أو إلى أن یتوقف الشیء على نفسه.
والدور یقع تارة بمرتبة واحدة ویسمى (دوراً مصرحاً)، ویقع أخرى بمرتبتین أو أکثر ویسمى (دوراً مضمراً).
1- (الدور المصرح) مثل: تعریف الشمس بأنها (کوکب یطلع فی النهار). والنهار لا یعرف إلا بالشمس إذ یقال فی تعریفه: (النهار: زمان تطلع فیه الشمس). فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، ومعرفة النهار حسب الفرض متوقفة على معرفة الشمس. والمتوقف على المتوقف على شیء متوقف على ذلک الشیء، فینتهی الأمر بالأخیر إلى أن تکون معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس.
2- (الدور المضمر) مثل: تعریف الاثنین بأنهما زوج أول. والزوج یعرف بأنه منقسم بمتساویین. والمتساویان یعرفان بأنهما شیئان أحدهما یطابق الآخر. والشیئان یعرفان بأنهما اثنان. فرجع الأمر بالأخیر إلى تعریف الاثنین بالاثنین.
وهذا دور مضمر فی ثلاث مراتب، لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط حتى تنتهی الدورة إلى نفس المعرَّف (بالفتح) الأول. والوسائط فی هذا المثال ثلاث: الزوج، المتساویان، الشیئان.
الخامس ـ أن تکون الألفاظ المستعملة فی التعریف ناصعة واضحة لا إبهام فیها، فلا یصح استعمال الألفاظ الوحشیة والغریبة، ولا الغامضة، ولا المشترکة والمجازات بدون القرینة، أما مع القرینة فلا بأس کما قدمت ذلک فی بحث المشترک والمجاز. وإن کان یحسن ـ على کل حال ـ اجتناب المجاز فی التعاریف والأسالیب العلمیة.۔
القسمة: تعریفها، فائدتها
تعریفها:
قسمة الشیء: تجزئته وتفریقه إلى أمور متباینة. وهی من المعانی البدیهیة الغنیة عن التعریف، وما ذکرناه فإنما هو تعریف لفظی لیس إلا. ویسمى الشَّیء (مقسَّماً)، وکل واحد من الأمور التی انقسم إلیها (قسماً)، تارة بالقیاس إلى نفس المقسم، و(قسیماً) أخرى بالقیاس إلى غیره من الأقسام. فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصدیق مثلاً، فالعلم مقسم، والتصور قسم من العلم وقسیم للتصدیق. وهکذا التصدیق قسم وقسیم
. فائدتها: تأسست حیاة الإنسان کلها على القسمة، وهی من الأمور الفطریة التی نشأت معه على الأرض: فإن أول شیء یصنعه تقسیم الأشیاء إلى سماویة وأرضیة، والموجودات الأرضیة إلى حیوانات وأشجار وأنهار وأحجار وجبال ورمال وغیرها. وهکذا یقسم ویقسم ویمیز معنى عن معنى ونوعاً عن نوع. حتى تحصل له مجموعة من المعانی والمفاهیم... وما زال البشر على البشر حتى استطاع أن یضع لکل واحد من المعانی التی توصل إلیها فی التقسیم لفظاً من الألفاظ. ولولا القسمة لما تکثرت عنده المعانی ولا الألفاظ.
ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقیق تلک الأنواع، وتمییزها تمییزاً ذاتیاً. ولا یزال العلم عند الإنسان یکشف له کثیراً من الخطأ فی تقسیماته وتنویعاته، فیعدِّلها.
ویکشف له أنواعاً لم یکن قد عرفها فی الموجودات الطبیعیة، أو الأمور التی یخترعها منها ویؤلفها، أو مسائل العلوم والفنون.
وسیأتی کیف نستعین بالقسمة على تحصیل الحدود والرسوم وکسبها، بل کل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة. وهذا أهم فوائد القسمة.
وتنفع القسمة فی تدوین العلوم والفنون، لتجعلها أبواباً وفصولاً ومسائل متمیزة، لیستطیع الباحث أن یلحق ما یعرض علیه من القضایا فی بابها، بل العلم لا یکون علماً ذا أبواب ومسائل وأحکام إلا بالقسمة: فمدون علم النحو ـ مثلاً ـ لابد أن یقسم الکلمة أولاً، ثم یقسم الاسم مثلاً إلى نکرة ومعرفة، والمعرفة إلى أقسامها، ویقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، وکذلک الحرف وأقسام کل واحد منها، ویذکر لکل قسم حکمه المختص به... وهکذا فی جمیع العلوم.
والتاجر ـ أیضاً ـ یلتجئ إلى القسمة فی تسجیل دفتره وتصنیف أمواله، لیسهل علیه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته. وکذلک بانی البیت، ومرکب الأدوات الدقیقة یستعین على إتقان عمله بالقسمة. والناس من القدیم قسموا الزمن إلى قرون وسنین وأشهر وأیام وساعات ودقائق لینتفعوا بأوقاتهم ویعرفوا أعمارهم وتاریخهم.
و صاحب المکتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفین، لیدخل أی کتاب جدید یأتیه فی بابه، ولیستخرج بسهولة أی کتاب یشاء. وبواسطة القسمة استعان علماء التربیة على توجیه طلاب العلوم، فقسموا المدارس إلى ابتدائیة وثانویة وعالیة، ثم کل مدرسة إلى صفوف، لیضعوا لکل صف ومدرسة منهاجاً یناسبه من التعلیم.
وهکذا تدخل القسمة فی کل شأن من شؤون حیاتنا العلمیة والاعتیادیة، ولا یستغنی عنها إنسان. ومهمتنا منها هنا أن نعرف کیف نستعین بها على تحصیل الحدود والرسوم.
(هامش):
القسمة من المباحث التی عنی بها المناطقة فی العصر الحدیث، وظنوا أنها من المباحث التی تفتق عنها الفکر الغربی. غیر أن فلاسفة اﻹسلام سبقوا إلى التنبیه علیها، وقد ذکرها الشیخ الطوسی العظیم فی منطق التجرید لتحصیل الحدود واکتسابها، وأوضحها العلامة الحلی فی شرحه الجوهر النضید.
***
أصول القسمة
1- لابد من ثمرة:
لا تحسن القسمة إلا إذا کان للتقسیم ثمرة نافعة فی غرض المقسِم، بأن تختلف الأقسام فی الممیزات والأحکام المقصودة فی موضع القسمة: فإذا قسم النحوی الفعل إلى أقسامه الثلاثة فلأن لکل قسم حکماً یختص به. أما إذا أراد أن یقسم الفعل الماضی إلى مضموم العین ومفتوحها ومکسورها، فلا یحسن منه ذلک، لأن الأقسام کلها لها حکم واحد فی علم النحو هو البناء، فیکون التقسیم عبثاً ولغواً، بخلاف مدون علم الصرف فإنه یصح له مثل هذا التقسیم لانتفاعه به فی غرضه من تصریف الکلمة.
وإذا لم نقسم نحن الدلالتین العقلیة والطبعیة فی الباب الأول إلى لفظیة وغیر لفظیة، لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسیم فی غرض المنطقی، کما أشرنا إلى ذلک هناک فی التعلیقة. 2- لابد من تباین الأقسام:
ولا تصح القسمة إلا إذا کانت الأقسام متباینة غیر متداخلة، لا یصدق أحدها على ما صدق علیه الآخر، ویشیر إلى هذا الأصل تعریف القسمة نفسه: فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى: مفعول، وحال، وتمییز، وظرف، فهذا التقسیم باطل، لأن الظرف من أقسام المفعول فلا یکون قسیماً له. ومثل هذا ما یقولون عنه: «یلزم منه أن یکون قسم الشیء قسیماً له». وبطلانه من البدیهیات.
ومثل هذا لو قسمنا سکان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنیاء وفقراء ومرضى وأصحاء. ویقع مثل هذا التقسیم کثیراً لغیر المنطقیین الغافلین ممن یرسل الکلام على عواهنه ولکنه لا ینطبق على هذا الأصل الذی قررناه، لأن الأغنیاء والفقراء لابد أن یکونوا علماء أو جهلاء، مرضى أو أصحاء، فلا یصح إدخالهم مرة ثانیة فی قسم آخر. وفی المثال ثلاث قسمات جمعت فی قسمة واحدة. والأصل فی مثل هذا أن تقسم السکان أولاً إلى علماء وجهلاء، ثم کل منهما إلى أغنیاء وفقراء، فتحدث أربعة أقسام، ثم کل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء، فتکون الأقسام ثمانیة: علماء أغنیاء مرضى، علماء أغنیاء أصحاء... إلى آخره. فتفطَّن لما یرد علیک من القسمة، لئلا تقع فی مثل هذه الغلطات.
ویتفرع على هذا الأصل أمور:
1- أنه لا یجوز أن تجعل قسم الشیء قسیماً له ـ کما تقدم ـ مثل أن تجعل الظرف قسیماً للمفعول.
2- ولا یجوز أن تجعل قسیم الشیء قسماً منه، مثل أن تجعل الحال قسماً من المفعول. 3- ولا یجوز أن تقسم الشیء إلى نفسه وغیره.
وقد زعم بعضهم أن تقسیم العلم إلى التصور والتصدیق من هذا الباب، لما رأى أنهم یفسرون العلم بالتصور المطلق، ولم یتفطن إلى معنى التصدیق مع أنه تصور أیضاً ولکنه تصور مقید بالحکم کما أن قسیمه خصوص التصور الساذج المقید بعدم الحکم. کما شرحناه سابقاً. أما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذی هو نفس العلم.
3- أساس القسمة:
ویجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد، أی یجب أن یلاحظ فی المقسم جهة واحدة، وباعتبارها یکون التقسیم، فإذا قسمنا کتب المکتبة فلابد أن نؤسس تقسیمها إما على أساس العلوم والفنون أو على أسماء المؤلفین أو على أسماء الکتب. أما إذا خلطنا بینها فالأقسام تتداخل ویختل نظام الکتب، مثل ما إذا خلطنا بین أسماء الکتب والمؤلفین، فنلاحظ فی حرف الألف مثلاً تارة اسم الکتاب وأخرى اسم المؤلف، بینما أن کتابه قد یدخل فی حرف آخر.
والشیء الواحد قد یکون مقسماً لعدة تقسیمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة أی (أساس القسمة)، کما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغیره وأخرى إلى مترادف ومتباین وثالثة إلى مفرد ومرکب، وکما قسمنا الفصل إلى قریب وبعید مرة وإلى مقوم ومقسم أخرى... ومثله کثیر فی العلوم وغیرها.
4- جامعة مانعة:
ویجب فی القسمة أن یکون مجموع اﻷقسام مساویاً للمقسم فتکون جامعة مانعة: جامعة لجمیع ما یمکن أن یدخل فیه من اﻷقسام أی حاصرة لها لا یشذ منها شیء، مانعة عن دخول غیر أقسامه فیه.
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
© جملہ حقوق 2014 - 2022 محفوظ ہیں۔
انواع القسمة
للقسمة نوعان أساسیان:
1- قسمة الکل إلى أجزائه، أو (القسمة الطبیعیة).
کقسمة الإنسان إلى جزئیه: الحیوان والناطق، بحسب التحلیل العقلی، إذ یحلل العقل مفهوم الإنسان إلى مفهومین: مفهوم الجنس الذی یشترک معه به غیره، ومفهوم الفصل الذی یختص به ویکون به الإنسان إنساناً. وسیأتی معنى التحلیل العقلی مفصلا. وتسمى حینئذٍ أجزاء عقلیة.
وکقسمة الماء إلى عنصرین: الأوکسجین والهیدروجین، بحسب التحلیل الطبیعی. ومن هذا الباب قسمة کل موجود إلى عناصره اﻷولیة البسیطة، وتسمى اﻷجزاء طبیعیة أو عنصریة. وکقسمة الحبر إلى ماء ومادة ملونة مثلاً، والورق إلى قطن ونوره، والزجاج إلى رمل وثانی أکسید السلکون. وذلک بحسب التحلیل الصناعی فی مقابل الترکیب الصناعی. واﻷجزاء تسمى أجزاء صناعیة.
وکقسمة المتر إلى أجزائه بحسب التحلیل الخارجی إلى اﻷجزاء المتشابهة أو کقسمة السریر إلى الخشب والمسامیر بحسب التحلیل الخارجی إلى اﻷجزاء غیر المتشابهة. ومثله قسمة البیت إلى اﻵجر والجص والخشب والحدید، أو إلى الغرفة والسرداب والسطح والساحة، وقسمة السیارة إلى آلاتها المرکبة منها، والإنسان إلى لحم ودم وعظم وجلد وأعصاب..
2- قسمة الکلی إلى جزئیاته، أو (القسمة المنطقیة).
کقسمة الموجود إلى مادة ومجرد عن المادة، والمادة إلى جماد ونبات وحیوان، وکقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف... وهکذا. وتمتاز القسمة المنطقیة عن الطبیعیة أن اﻷقسام فی المنطقیة یجوز حملها على المقسم وحمل المقسم علیها فنقول: هذا الاسم مفرد، والمفرد اسم. ولا یجوز الحمل فی الطبیعیة عدا ما کانت بحسب التحلیل العقلی، فلا یجوز أن تقول البیت سقف أو جدار ولا الجدار بیت.
ولابد فی القسمة المنطقیة من فرض جهة وحدة جامعة فی المقسم تشترک فیها اﻷقسام وبسببها یصح الحمل بین المقسم واﻷقسام، کما لابد من فرض جهة افتراق فی اﻷقسام على وجه یکون لکل قسم جهة تباین جهة القسم اﻵخر، وإلا لما صحت القسمة وفرض اﻷقسام. وتلک الجهة الجامعة إما أن تکون مقومة للأقسام أی داخلة فی حقیقتها بأن کانت جنساً أو نوعاً وإما أن تکون خارجة عنها.
1- إذا کانت الجهة الجامعة مقومة للأقسام، فلها ثلاث صور:
أ- أن تکون جنساً، وجهات الافتراق الفصول المقومة للأقسام، کقسمة المفرد إلى الاسم والفعل والحرف... فیسمى التقسیم (تنویعاً) والأقسام أنواعاً.
ب- أن تکون جنساً أو نوعاً، وجهات الافتراق العوارض العامة اللاحقة للمقسم، کقسمة الاسم إلى مرفوع ومجرور، فیسمى التقسیم (تصنیفاً) والأقسام أصنافاً.
ج- أن تکون جنساً أو نوعاً أو صنفاً، وجهات الافتراق العوارض الشخصیة اللاحقة لمصادیق المقسم، فیسمى التقسیم (تفریداً) والأقسام أفراداً، کقسمة الإنسان إلى زید وعمرو ومحمد وحسن... إلى آخرهم باعتبار المشخصات لکل جزئی جزئی منه.
2- إذا کانت الجهة الجامعة خارجة عن الأقسام، فهی کقسمة اﻷبیض إلى الثلج والقطن وغیرهما، وکقسمة الکائن الفاسد إلى معدن ونبات وحیوان، وکقسمة العالم إلى غنی وفقیر أو إلى شرقی وغربی... وهکذا.
***
اسالیب القسمة
ﻷجل أن نقسم الشیء قسمة صحیحة لابد من استیفاء جمیع ما له من اﻷقسام، کما تقدم فی اﻷصل الرابع، بمعنى أن تکون القسمة حاصرة لجمیع جزئیاته أو أجزائه. ولذلک أسلوبان:
1- طریقة القسمة الثنائیة:
وهی طریقة التردید بین النفی والإثبات، والنفی والإثبات (وهما النقیضان) لا یرتفعان أی لا یکون لهما قسم ثالث ولا یجتمعان أی لا یکونان قسماً واحداً، فلا محالة تکون هذه القسمة ثنائیة أی لیس أکثر من قسمین، وتکون حاصرة جامعة مانعة، کتقسیمنا للحیوان إلى ناطق وغیر ناطق. وغیر الناطق یدخل فیه کل ما یفرض من باقی أنواع الحیوان غیر الإنسان لا یشذ عنه نوع، وکتقسیمنا للطیور إلى جارحة وغیر جارحة، والإنسان إلى عربی وغیر عربی، والعالم إلى فقیه وغیر فقیه... وهکذا.
ثم یمکن أن نستمر فی القسمة فنقسم طرف النفی أو طرف الإثبات أو کلیهما إلى طرفین إثبات ونفی، ثم هذه اﻷطراف اﻷخیرة یجوز أن تجعلها أیضاً مقسماً فتقسمها أیضاً بین الإثبات والنفی... وهکذا تذهب إلى ما شئت أن تقسم إذا کانت هناک ثمرة من التقسیم.
مثلاً إذا أردت تقسیم الکلمة، فتقول:
1- الکلمة تنقسم إلى: ما دل على الذات وغیره
2- طرف النفی (الغیر) إلى: ما دل على الزمان وغیره
فتحصل لنا ثلاثة أقسام: ما دلّ على الذات وهو (الاسم)، وما دلّ على الزمان وهو (الفعل)، وما لم یدل على الذات والزمان وهو (الحرف). والتعبیر المألوف عند المؤلفین أن یقال: «الکلمة إما أن تدل على الذات أو لا، واﻷول الاسم، والثانی إما أن تدل على الزمان أو لا؛ واﻷول الفعل؛ والثانی الحرف».
(مثال ثان) إذا أردنا تقسیم الجوهر إلى أنواعه فیمکن تقسیمه على هذا النحو:
ینقسم 1- الجوهر إلى: ما یکون قابلاً للأبعاد وغیره
2- ثم طرف الإثبات (القابل) إلى: نام وغیره
3- ثم طرف النفی (غیر النامی) إلى: جامد وغیره
4- ثم طرف الإثبات فی التقسیم (2) إلى: حساس وغیره
وهکذا یمکن أن تستمر بالقسمة حتى تستوفی أقسام الحساس إلى جمیع أنواع الحیوان.
ولک أیضاً أن تقسم الجامد وغیر الحساس. وقد رأیت أنا قسمنا تارة طرف الإثبات وأخرى طرف النفی.
وهذه القسمة الثنائیة تنفع على اﻷکثر فی الشیء الذی لا تنحصر أقسامه، وإن کانت مطولة، ﻷنک تستطیع بها أن تحصر کل ما یمکن أن یفرض من اﻷنواع أو اﻷصناف بکلمة (غیره)، ففی المثال اﻷخیر ترى (غیر الناهق) یدخل فیه جمیع ما للحیوان من اﻷنواع غیر الناطقة والصاهلة والناهقة، فاستطعت أن تحصر کل ما للحیوان من أنواع.
وتنفع هذه القسمة أیضاً فیما إذا أرید حصر اﻷقسام حصراً عقلیاً کما یأتی، وتنفع أیضاً فی تحصیل الحد والرسم. وسیأتی بیان ذلک.
2- طریقة القسمة التفصیلیة:
وذلک بأن تقسم الشیء ابتداء إلى جمیع أقسامه المحصورة کما لو أردت أن تقسم الکلی إلى: نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام.
والقسمة التفصیلیة على نوعین عقلیة واستقرائیة:
1- (العقلیة): وهی التی یمنع العقل أن یکون لها قسم آخر، کقسمة الکلمة المتقدمة، ولا تکون القسمة عقلیة إلاّ إذا بنیتها على أساس النفی والاثبات: (القسمة الثنائیة) فلأجل إثبات أن القسمة التفصیلیة عقلیة یرجعونها إلى القسمة الثنائیة الدائرة بین النفی والاثبات، ثم إذا کانت اﻷقسام أکثر من اثنین یقسمون طرف النفی أو الاثبات إلى النفی والإثبات... وهکذا کلما کثرت اﻷقسام، على ما تقدم فی الثنائیة.
2- (الاستقرائیة): وهی التی لا یمنع العقل من فرض آخر لها، وإنما تذکر اﻷقسام الواقعة التی علمت بالاستقراء والتتبع، کتقسم اﻷدیان السماویة إلى: الیهودیة والنصرانیة واﻹسلامیة وکتقسیم مدرسة معینة إلى: صف أول وثان وثالث، عندما لا یکون غیر هذه الصفوف فیها، مع إمکان حدوث غیرها.
***
التعریف بالقسمة
إن القسمة بجمیع أنواعها هی عارضة للمقسم فی نفسها، خاصة به غالباً.
ولما اعتبرنا فی القسمة أن تکون جامعة مانعة فالأقسام بمجموعها مساویة للمقسم، کما أنها غالباً تکون أعرف منه. وعلیه یجوز تعریف المقسم بقسمته إلى أنواعه أو أصنافه، ویکون من باب تعریف الشیء بخاصته. وهو التعریف بالرسم الناقص، کما کان التعریف بالمثال من هذا الباب. ولنضرب لک مثلاً لذلک: أنا إذا قسمنا الماء بالتحلیل الطبیعی إلى أوکسجین وهیدروجین وعرفنا أن غیره من اﻷجسام لا ینحلّ إلى هذین الجزأین، فقد حصل تمییز الماء تمییزاً عرضیّاً عن غیره بهذه الخاصة، فیکون ذلک نوعاً من المعرفة للماء المطمئن إلیها. وکذا لو عرفنا أن الورق ینحل إلى القطن والنورة مثلاً نکون قد عرفناه معرفة نطمئن إلیها تمیزه عن غیره.. وهکذا فی جمیع أنواع القسمة.
کسب التعریف بالقسمة أو کیف نفکر لتحصیل المجهول التصوری:
أنت تعرف أن المعلوم التصوری منه ما هو بدیهی لا یحتاج إلى کسب کمفهوم الوجود والشیء، ومنه ما هو نظری تحتاج معرفته إلى کسب ونظر.
ومعنى حاجتک فیه إلى الکسب أن معناه غیر واضح فی ذهنک وغیر محدد ومتمیز، أو فقل غیر مفهوم لدیک ولا معروف، فیحتاج إلى التعریف، والذی یعرّفه للذهن هو الحد والرسم. ولیس الحد أو الرسم للنظری موضوعاً فی الطریق فی متناول الید، وإلا فما فرضته نظریاً مجهولاً لم یکن کذلک بل کان بدیهیاً معروفاً. فالنظری عندک فی الحقیقة لیس هو إلا الذی تجهل حده أو رسمه. إذن، المهم فی اﻷمر أن نعرف الطریقة التی نحصل بها الحد والرسم. وکل ما تقدم من اﻷبحاث فی التعریف هی فی الحقیقة أبحاث عن معنى الحد والرسم وشروطهما أو أجزائهما. وهذا وحده غیر کافٍ ما لم نعرف طریقة کسبهما وتحصیلهما، فإنه لیس الغنی هو الذی یعرف معنى النقود وأجزاءها وکیف تتألف، بل الغنی من یعرف طریقة کسبها فیکسبها، ولیس المریض یشفى إذا عرف فقط معنى الدواء وأجزاءه بل لابد أن یعرف کیف یحصله لیتناوله.
وقد أغفل کثیر من المنطقیین هذه الناحیة، وهی أهم شیء فی الباب. بل هی اﻷساس، وهی معنى التفکیر الذی به نتوصل إلى المجهولات. ومهمتنا فی المنطق أن نعرف کیف نفکر لنکسب العلوم التصوریة والتصدیقیة.
وسیأتی أن طریقة التفکیر لتحصیل العلم التصدیقی هو الاستدلال والبرهان. أما تحصیل العلم التصوری فقد اشتهر عند المناطقة أن الحد لا یکتسب بالبرهان، وکذا الرسم. والحق معهم ﻷن البرهان مخصوص لاکتساب التصدیق، ولم یحن الوقت بعد لأُبیِّن للطالب سرّ ذلک، وإذا لم یکن البرهان هی الطریقة هنا فما هی طریقة تفکیرنا لتحصیل الحدود والرسوم؟ وطبعاً لابدّ أن تکون هذه الطریقة طریقة فطریة یصنعها کل إنسان فی دخیلة نفسه یخطئ فیها أو یصیب. ولکن نحتاج إلى الدلالة علیها لنکون على بصیرة فی صناعتها. وهذا هو هدف علم المنطق. وهذا ما نرید بیانه، فنقول:
الطریق منحصر بنوعین من القسمة: القسمة الطبیعیة بالتحلیل العقلی وتسمى طریقة التحلیل العقلی، والقسمة المنطقیة الثنائیة. ونحن أشرنا فی غضون کلامنا فی التعریف والقسمة إلى ذلک. وقد جاء وقت بیانه فنقول:
طریقة التحلیل العقلی
***
طریقة التحلیل العقلی
إذا توجهت نفسک نحو المجهول التصوری (المشکل)، ولنفرضه (الماء) مثلاً عندما یکون مجهولاً لدیک ـ وهذا هو الدور اﻷول ـ فأول ما یجب أن تعرفه نوعه. أی تعرف أنه داخل فی أی جنس من اﻷجناس العالیة أو ما دونها، کأن تعرف أن الماء ـ مثلاً ـ من السوائل. وهذا هو (الدور الثانی). وکلما کان الجنس الذی عرفت دخول المجهول تحته قریباً کان الطریق أقصر لمعرفة الحد أو الرسم. وسیتضح.
وإذا اجتزت الدور الثانی الذی لابدّ منه لکل من أراد التفکیر بأیة طریقة کانت، انتقلت إلى الطریقة التی تختارها للتفکیر ولابدّ أن تتمثل فیها اﻷدوار الثلاثة اﻷخیرة أو الحرکات الثلاث التی ذکرناها للفکر: الذاهبة والدائریة والراجعة.
وإذ نحن اخترنا اﻵن (طریقة التحلیل العقلی) أولاً، فلنذکرها متمثلة فی الحرکات الثلاث: فإنک عندما تجتاز الدور الثانی تنتقل إلى الثالث وهو الحرکة الذاهبة حرکة العقل من المجهول إلى المعلومات. ومعنى هذه الحرکة بطریقة التحلیل المقصود بیانها هو أن تنظر فی ذهنک إلى جمیع اﻷفراد الداخلة تحت ذلک الجنس الذی فرضت المشکل داخلاً تحته. وفی المثال تنظر إلى أفراد السوائل سواء کانت ماء أو غیر ماء باعتبار أن کلها سوائل.
وهنا ننتقل إلى الرابع، وهو (الحرکة الدائریة) أی حرکة العقل بین المعلومات. وهو أشق اﻷدوار وأهمها دائماً فی کل تفکیر، فإن نجح المفکر فیه، انتقل إلى الدور اﻷخیر الذی به حصول العلم، وإلا بقی فی مکانه یدور على نفسه بین المعلومات من غیر جدوى. وهذه الحرکة الدائریة بین المعلومات فی هذه الطریقة، هی أن یلاحظ الفکر مجامیع أفراد الجنس الذی دخل تحته المشکل، فیفرزها مجموعة مجموعة، فلأفراد المجهول مجموعة، ولغیره من أنواع الجنس اﻷخرى کل واحد مجموعة من اﻷفراد. وفی المثال یلاحظ مجامیع السوائل: الماء، والزئبق، واللبن،
والدهن، إلى آخرها. وعند ذلک یبدأ فی ملاحظتها ملاحظة دقیقة، لیعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشکل بحسب ذاتها وحقیقتها عن المجامیع اﻷخرى، أو بحسب عوارضها الخاصة بها.
ولابد هنا من الفحص الدقیق والتجربة لیعرف فی المثال الخصوصیة الذاتیة أو العرضیة التی یمتاز بها الماء عن غیره من السوائل، فی لونه وطعمه، أو فی وزنه وثقله، أو فی أجزائه الطبیعیة. ولا یستغنی الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم. والبشر من القدیم ـ کما قلنا فی أول مبحث القسمة ـ اهتموا بفطرتهم فی تقسیم اﻷشیاء وتمییز اﻷنواع بعضها عن بعض، فحصلت لهم بمرور الزمن الطویل معلومات قیمة هی ثروتنا العلمیة التی ورثناها من أسلافنا. وکل ما نستطیعه من البحث فی هذا الشأن هو التعدیل والتنقیح فی هذه الثروة، واکتشاف بعض الکنوز من اﻷنواع التی لم یهتد إلیها السابقون، على مرور الزمن وتقدم المعارف.
فإن استطاع الفکر أن ینجح فی هذا الدور (الحرکة الدائریة) بأن عرف ما یمیز المجهول تمییزاً ذاتیاً أی عرف فصله، أو عرف ما یمیزه تمییزاً عرضیاً أی عرف خاصته، فإن معنى ذلک أنه استطاع أن یحلل معنى المجهول إلى جنس وفصل، أو جنس وخاصة، تحلیلاً عقلیاً، فیکمل عنده الحد التام أو الرسم التام بتألیفه مما انتهى إلیه التحلیل. کما لو عرف الماء فی المثال بأنه سائل بطبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحة أو أنه له ثقل نوعی مخصوص أو أنه قوام کل شیء حی.
ومعنى کمال الحد أو الرسم عنده قد انتهى إلى الدور اﻷخیر، وهو (الحرکة الراجعة) أی حرکة العقل من المعلوم إلى المجهول. وعندها ینتهی التفکیر بالوصول إلى الغایة من تحصیل المجهول.
وبهذا اتضح معنى التحلیل العقلی الذی وعدناک ببیانه سابقاً فی القسمة الطبیعیة، وهو إنما یکون باعتبار المتشارکات والمتباینات، أی أنه بعد ملاحظة المتشارکات بالجنس یفرزها ویوزعها مجامیع أو فقل أنواعاً بحسب ما فیها من الممیزات المتباینة فیستخرج من هذه العملیة الجنس والفصل مفردات الحد، أو الجنس والخاصة مفردات الرسم، فکنت بذلک حللت المفهوم المراد تعریفه إلى مفرداته.
(تنبیه):
إن الکلام المتقدم فی الدور الرابع فرضناه فیما إذا کنت من أول اﻷمر، لما عرفت نوع المشکل، عرفت جنسه القریب، فلم تکن بحاجة إلا للبحث عن ممیزاته عن اﻷنواع المشترکة معه فی ذلک الجنس.
أما لو کنت قد عرفت فقط جنسه العالی کأن عرفت أن الماء جوهر لا غیر، فإنک ﻷجل أن تکمل لک المعرفة، لابد أن تفحص (أولاً) لتعرف أن المشکل من أی اﻷجناس المتوسطة، بتمییز بعضها عن بعض بفصولها أو خواصها على نحو العملیة التحلیلیة السابقة، حتى تعرف أن الماء جوهر ذو أبعاد أی جسم.
ثم تفحص (ثانیاً) بعملیة تحلیلیة أخرى لتعرفه من أی اﻷجناس القریبة هو، فتعرف أنه سائل، ثم تفحص (ثالثاً) بتلک العملیة التحلیلیة لتمیزه عن السوائل اﻷخرى بثقله النوعی مثلاً أو بأنه قوام کل شیء حی، فیتألف عندک تعریف الماء على هذا النحو مثلاً (جوهر ذو أبعاد سائل قوام کل شیء حی) ویجوز أن تکتفی عن ذلک فتقول (سائل قوام کل شیء حی) مقتصراً على الجنس القریب.
وهذه الطریقة الطویلة من التحلیل التی هی عبارة عن عدة تحلیلات یلتجئ إلیها اﻹنسان إذا کانت اﻷجناس متسلسلة ولم یکن یعرف الباحث دخول المجهول إلا فی الجنس العالی. ولکن تحلیلات البشر التی ورثناها تغنینا فی أکثر المجهولات عن إرجاعها إلى اﻷجناس العالیة، فلا نحتاج على اﻷکثر إلا لتحلیل واحد لنعرف به ما یمتاز به المجهول عن غیره.
على أنه یجوز لک أن تستغنی بمعرفة الجنس العالی أو المتوسط، فلا تجری إلا عملیة واحدة للتحلیل لتمیز المشکل عن جمیع ما عداه مما یشترک معه فی ذلک الجنس العالی أو المتوسط، غیر أن هذه العملیة لا تعطینا إلا حداً ناقصاً أو رسماً ناقصاً.
***
م
طریقة القسمة المنطقیة الثنائیة
إنک بعد الانتهاء من الدورین اﻷولین أی دور مواجهة المشکل ودور معرفة نوعه، لک أن تعمد إلى طریقة أخرى من التفکیر تختلف عن السابقة.
فإن السابقة کانت النظرة فیها إلى اﻷفراد المشترکة فی ذلک الجنس ثم تمییزها بعضها عن بعض لاستخراج ما یمیز المجهول.
أما هذه فإنک تتحرک إلى الجنس الذی عرفته فتقسمه بالقسمة المنطقیة الثنائیة إلى إثبات ونفی: الإثبات بما یمیز المجهول تمییزاً ذاتیاً أو عرضیاً، والنفی بما عداه. وذلک إذا کان المعروف الجنس القریب، فتقول فی مثال الماء الذی عرف أنه سائل: (السائل إما عدیم اللون وإما غیره)، فتستخرج بذلک الحد التام أو الرسم التام وتحصل لدیک الحرکات الثلاث کلها.
أما لو کان الجنس الذی عرفته هو الجنس العالی أو المتوسط فإنک تأخذ أولاً الجنس العالی مثلاً، فتقسمه بحسب الممیزات الذاتیة أو العرضیة، ثم تقسم الجنس المتوسط الذی حصلته بالتقسیم اﻷول إلى أن یصل التقسیم إلى اﻷنـواع السافلة ـ على النحو الذی مثلنا به فی القسمة الثنائیة للجوهر ـ وبهذا تصیر الفصول کلها معلومة على الترتیب فتعرف بذلک جمیع ذاتیات المجهول على التفصیل.
***

About this course
منطق